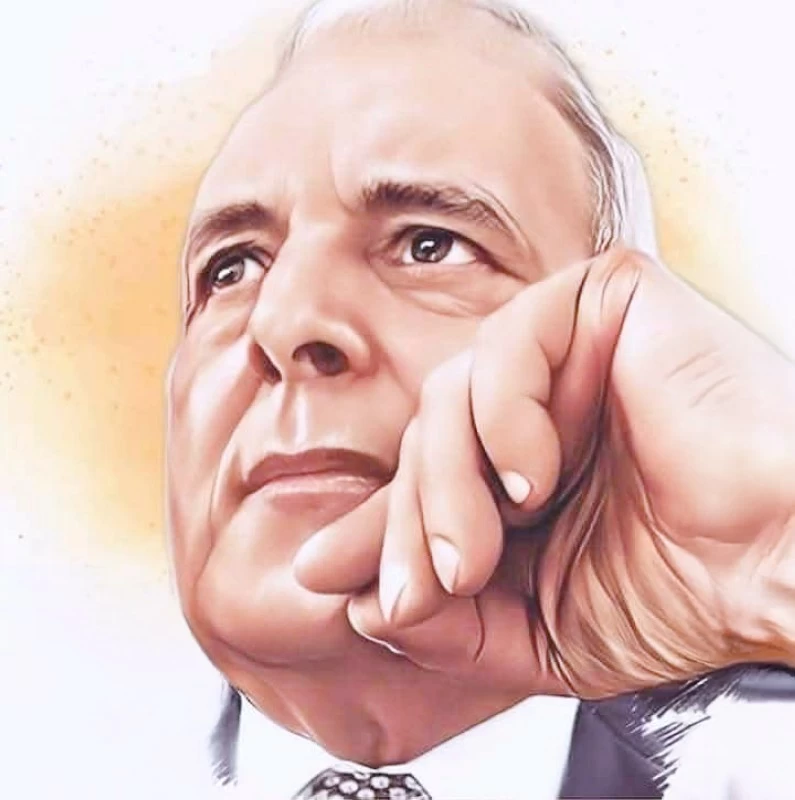يُروى عن التابعي مالك بن دينار، أنه شرح آيات من مصحفه، ثم وضعه على رف بالمسجد، وقام يصلي بالناس، وعقب الصلاة، تلفّت فلم يجد المصحف، فعلم أنه سُرِقَ، فوعظ الحضور وسألهم: أين المصحف؟ فملأ النحيب جنبات المكان، فقال مقولته: كُلّنا يبكي فمن سرق المصحف؟
هل يضبط الوعظ أخلاق الناس، أم أن تشريعات وأنظمة الدولة أقوى وأبلغ منه؟ يُفترض مع هذا الكم من الوعظ أن نغدو ملائكة، ولعلنا نثير أسئلة عن دور الوعظ وهل لا يزال مفيداً، أو أنه أكثر من الحاجة، أو أنه انتهى عصر الواعظ التقليدي، وبدأ عصر الواعظ التقني، والفقيه الروبوت، والمنبه الإلكتروني.
عندما يضعف دور الوازع الأخلاقي، أو يموت ضمير الواعظ والموعوظ يتحتم على الدولة أن تتدخل بسن القوانين والأنظمة والإجراءات الملزمة التي تجعل كل مواطن أو مقيم يضبط قوله وفعله ويقف عند حدوده ولا يتجاوزها.
لستُ أدري هل ما زال هناك من المسلمين جُهال بالحلال والحرام؟ إذا كان الجواب «بلا» فما سر هذا السيل من الوعظ هذه الأيام؟ خصوصاً عبر التواصل، الواعظ يعظ والطبيب والمهندس والمعلّم والتاجر والنصّاب والراعي والمزارع واللاعب والطالب والمطلوب، (الكل في بذل النصائح جاهدٌ، فعلى التواصل كُلّنا وعاظُ)!
كم من الخطب والمواعظ والنصائح أُلقيت طيلة التاريخ الإسلامي؟ فما أثرها على أخلاق المسلمين؟ لماذا إلى اليوم نرى ونسمع ونعيش ونعايش ظلم وجور وغش وتجاوز وانحراف وكراهية وكذب وفجور بعض المسلمين على بعض حتى الأقربين منهم.
من المسلّم به أن القرار السياسي الحازم، والتدافع التاريخي، يفرضان على المجتمع السوي، إثر طول احتراب، ومسيرة سوء ظن، وحقب تنازع، التفاعل والتسليم بالجديد وتخطي المراحل.
تكتسب الشعائر الدينية قيمتها من خلال تأثيرها الإيجابي على مقيميها. ولأي ديانة سماوية، أو ثقافة أرضية، ديناميكية، وغايات ومقاصد وآليات تطبيق، تتماهى مع الظروف الزمانية والمكانية، وتغيّر نمطيتها الضرورات الحتمية، ولو تركنا لبعض الفقهاء التقليديين حرية إلزام الناس بالصلوات في المساجد في ظل جائحة كورونا دون احترازات لألزموهم ولحظيت فتاواهم بمن يستجيب لها دون أي تردد.
هذا يؤكد أن لدينا قابلية فطرية للوصاية باسم الدِّين، وهذا ما استغلته الصحوة أسوأ استغلال بما في ذلك التصدي لبعض قرارات الدولة، بحكم أن عقلية الصحويين خيّلت لهم أن مسارهم مرتبط بالله مباشرة، ولا سلطة للدولة عليه، وبما أن عقلية الأتباع لا تسأل، ولا تُناقش، ولا تحتج، ولا تعترض فمن الطبيعي أن تنهال على الرموز هالة قداسة كشفت لنا الأيام أنهم ليسوا أهلاً لها.
ما يميّز التشريع المدني، أو النظامي، أنه قائم على المساواة بين مكونات المجتمع، وأن غايته المصلحة العظمى، ثم أنه نتاج الواقع، واستقراء خبرات للمتغيرات، ولا يهدف للتسلط باسم النظام، قدر ما يُرتّب ويعزز العلاقات البينية الاجتماعية، والاقتصادية، ويقوّي مكانة وهيبة الدولة التي لا تنطلق من أجندات خاصة، بل تسعى لحفظ وخدمة العام والخاص وفق مبدأ الحقوق والواجبات.
مما يُروى أن رجلاً كفيفاً ألزم نفسه بطلب العلم عند فقيه في قرية مجاورة، وكان يرتحل إليه يومياً، بمساعدة ابنته التي تعينه على ركوب الدابة، ثم تقودها لتوصل أباها لمسجد الفقيه، ثم تنتظره حتى ينتهي، وذات يوم وهما في الطريق طلب الأب التوقف لقضاء حاجة، فاقتلعت البنت حجراً مدبباً، وطلبت من والدها الكفيف التريّث حتى تُرخي له موضع البول، حتى لا تتسبب صلابة الأرض في انعكاس رذاذه على ملابسه، وبانتهائه من حاجته، قال لها: عودي بنا للبيت؟ فسألته: ولماذا؟ فأجاب: الفائدة التي أكسبها يومياً من الفقيه كسبتها منك، وتكفينا فائدة واحدة نطبقها ونعمل بها، وتغني عن عِلم لا يُعمل به.
ومن الحكايات الشعبية أن فقيه القرية البخيل خصص خطبة جُمعة عن الصدقة، وبحكم أن بيته ملاصق للمسجد، والزوجة تسمع الزوج يلعلع فوق المنبر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، الصدقة برهان، وما نقص مال من صدقة، فقررت اختبار زوجها الخطيب، وعندما عاد للبيت طالباً الغداء، قالت له: تصدّقتُ به على مسكين عابر عندما سمعتك تحث على الصدقة. فقال: يا مخلوقة تريني أحدّث للجماعة ما أحدّث لك.
قال الحق سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كَبُرَ مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».
علي بن محمد الرباعي
على التواصلِ كُلّنا وعّاظُ
16 أبريل 2021 - 00:06
|
آخر تحديث 16 أبريل 2021 - 00:06
تابع قناة عكاظ على الواتساب