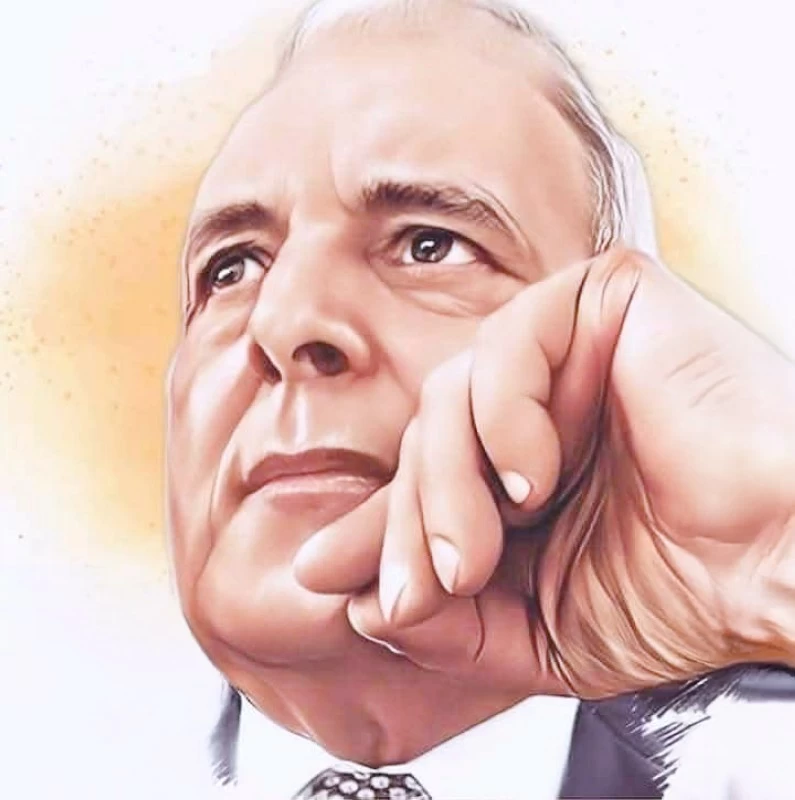لا يطمح عاقل مؤمن بالله واليوم الآخر لأكثر من الستر. وأبونا آدم عليه السلام عصى ربه، فكشف الله ستره، وأظهر سوءته، وأخرجه من جنّة كان لا يجوع فيها ولا يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يضحى، وأنزله إلى الغبراء؛ ليتأدب ويتوب، ولتكون أوّل إشارة تُصوّر تبعة الخطيئة على مرتكبها، واستحقاقه العقوبة، وتربط بين نقض العهد والفضح، والتمرد والطرد، دون إغفالٍ لمُراد الله القاضي سلفاً بإنزال آدم إلى الأرض واستخلافه فيها.
ومما طرق مسامعنا من أسلافنا (يا الله يا ذا سترت أمس تستر اليوم) ومن الدعاء الجاري على الألسن إذا بلغ أحدهم نبأ غير سار (يا رب سترك) و(اللهم استرنا بسترك فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض).
فالستر مطلب فطري ناجم عن الحياء من الله والاستحياء من خلقه، ويقابل الستر الهتك والكشف والفضح، ومن الأدعية المأثورة (اللهم لا تهتك لنا ستراً، ولا تفضح لنا سرّاً). وأول ردة فعل عند سماعنا نبأ مزعجاً قولنا: (يا رب سترك وعافيتك)، وكأنما الستر مطلب موازٍ ومكمّل لنعمة العافية، وشاعرنا الشعبي يقول: (يا الله اليوم يا ستّار، ما للاستار عيّنة).
ويعد بعض المفسرين (السّتِير) من أسماء الله الحُسنى، كونه جل وعلا يحب السِّتر، وفي الحديث (إنَّ اللهَ تعالى يُدنِي المؤمنَ يوم القيامة، فَيضَعُ عليهِ كَنفَه وسِتْرَه من النَّاسِ، ويُقرِّرُه بذُنوبِه فيقولُ: أَتعرِفُ ذَنبَ كَذا؟ أَتعرِفُ ذَنبَ كَذا؟ فيقولُ: نعَم أَيْ رَبِّ، حتَّى إذا قَرَّرَهُ بذُنوبِه ورَأى في نَفسِه أَنَّه قد هَلكَ، قال: فإنِّي قد سَترتُهَا عليكَ في الدُّنيا، وأنا أَغفِرُهَا لكَ اليومَ، ثم يُعطَي كتابَ حسناتِه بِيمينِه). وأجر الستيرين كبير، وفي الأثر (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)، و(من ستر مسلماً ستره الله في الدُنيا والآخرة) كما جاء النص القرآني بالأمر بغضّ البصر، والاستئذان قبل الدخول على الأهل أو الأجانب، خصوصاً وقت العورات الثلاث: (من بعد صلاتي العشاء والفجر وعند وضع الثياب في الظهيرة)؛ لكي لا يرى ما يسوء، ونهى الشرع عن التجسس، والغيبة، والنميمة، لأنها فضح يتنافى مع أدب الستر.
ومما يؤكد موقف الشرع الصارم مع متعقبي العورات، وكاشفي السوءات ما جاء في الحديث عن أبي هريرة (لَوْ أنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بغيرِ إذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بحَصاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ما كانَ عَلَيْكَ مِن جُناحٍ)، والفضول يدفع البعض إلى تعقب الحياة الشخصية للآخرين، والجرأة على استنطاقهم والتحقيق معهم: (منين جاي؟، وين رايح؟، من عندك؟، وش عندك بكرة؟) ومثلها أسئلة لا حصر لها، ولو أدخلت الناس ليعيشوا معك في بيتك لما ريّحوك، ولأظهروا في يومياتك مئات العيوب.
ومن مظاهر التعسف في استعمال التقنية تصوير الآخرين دون علمهم، ودون استئذان منهم، وربما كانوا في أوضاع خاصة لا يودون أن يراهم عليها أحد، وفي نظامنا من العقوبات ما يكفل ردع المتجرئ على خصوصية غيره.
أوردتُ (مستورة) في العنوان وصفاً لا اسماً، إذ كان بعض أهلنا إذا لقي رجلاً أو امرأة لا يعرفهما يناديهما بجملة (يا مستور الحال) ويا (مستورة الحال)، فيما إذا دعا مظلوم على ظالم قال (الله يكشف حالك) وفي الأمثال (ما يفضح ابن آدم إلا الموت، أو ديّان السوء) فالمستور مُعافى.
من المؤكد أن التقنية قاربت أنماط عيشنا، وغدونا في تفكيرنا واهتمامنا مثل بعضنا، وزالت الحدود الزمانية والمكانية بيننا وبين غيرنا، فطالنا هوس المحاكاة للآخر، دون انتباه للمسافة بين ثقافتنا وثقافته، واندفعنا في التقليد (القرداتي) ما أفقدنا الإحساس بقيمة الذات، ولا ريب أن الجهاز الجوال مجرد وسيلة اتصال وتواصل، إلا أنه يستمد قيمته ومعناه من غايات مُسْتَعْمِله ومالِكِه، ومما يؤسف له، اختراقه لثقافتنا، وجذبنا بسحره وغوايته لدوامته، والإيقاع بنا في مخالفات شرعية وقانونية.
وإذا كانت الحاسوبية، والهواتف الذكيّة، نعمة، فإن الواجب استثمارها في مرضاة الله بنفع البشرية، ورفع كفاءة القدرات التعليمية، وتعزيز البنى الاجتماعية والثقافية، وحماية الحدود الوطنية والذود عنها، لا تحويلها (لنادٍ ليلي) ينقل الفُحش، والبذاءة، ويُعرّي ما أمر الله بستره، عبر مجاهرة سافرة، وممارسات عاهرة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإنَّ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه».
والأسوياء يتمسكون بالستر المادي (اللباس) والمعنوي (الآداب)، بينما يخلع البعض أو تخلع رداء الحياء، لا لشيء سوى استجابة لإغراء تقني اقتحم حياتنا فأذعنّا له وسلّمناه أنفسنا وأهلنا، الطعام نصوره، والتسوق ننقله، والفسحة نعرضها، وأدخله البعض لغُرف نومه، ما يدل على قصور فهم لوظيفة التقنية، والدليل توظيفها في السُخف والبلاهة، وجرح الهويّة الدينية والوطنية، عوضاً عن الاستفادة منها في التعلّم والمهارة وإتقان الحِرف والإبداع الذي يرفع قيمة ومدخول الفرد والمجتمع.
هل غاية الكتابة والتصوير والتغريد والتسنيب العرض والإبهار، أم طرح الأفكار النيّرة ونشر الفضائل؟ وهل يحترم المجتمع ويُقدّر الإنسان الذوق أم عديم الذوق؟ ومن الأقرب لمشاعرنا المُحترم المحتشم أم فاقد الاحترام والاحتشام؟ وما هي اللذة أو المنفعة المترتبة على هتك ستر الخصوصية؟ هذه أسئلة ربما تدور في أذهان شرائح من مجتمع، يُعلي مكانة العفّة، ويشيد بالكائن المتربي على الأدب مع الله ومع النفس ومع الناس، ومن الواجب فتح باب النقاش مع بعضنا حول تداعيات العصر الرقمي وتبعاته؛ لتفادي الإضرار بأنفسنا وبالآخرين.
لا يدرك بعضنا كُنه الأجهزة التي يتعامل معها، يظن أنه هو المُتحكم بها، بينما الواقع هي التي تتحكم فيه، وربما لا يتأمل البعض ما سبق التقنية من فلسفات وأفكار وعِلم، فيقتني سُذّج أحدث الأجهزة الذكيّة ليعرضوا من خلالها غباءهم، ولينتهكوا بها خصوصية أفراد أسرتهم أو عوائلهم أطفالاً ونساء وإخوة وأخوات وآباء وأمهات.
يفضح البعض عَوَرَه، ويكشف سوءته، ويشرك العالم في مشاهدة ما أمر الشرع وحثت الأخلاق على ستره، فيرفع جلباب الاحترام، ويصدع قداسة الأم والأب، وينزع براءة الأطفال، ويقلع حشمة ووقار كبار السن، ويسلّع جسد الرجل والمرأة، ما يعني فقدان الحياء والحشمة واختلال ميزان القِيم الأخلاقية.
تجرّم الدول والحكومات انتهاك الخصوصية، وتضع التشريعات، وتُنزل أقسى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد النسيج الاجتماعي، أو الإساءة للحمة الوطنية، فالابتذال مذموم، والخلاعة والمجون مرفوضة؛ لأنها ليست من ثقافة مجتمعنا، ولا أدب إسلامنا، ولا رؤية وطننا، ولا توجّه قيادتنا، فالمرحلة الحالية تقوم على العلم والمعرفة، وتوظيف التقنية توظيفاً إيجابياً، تؤهلنا للاعتداد بذواتنا والفخر بكريم صفاتنا، ومن الواجب أن نكون عوناً وسنداً للإنسانية بأرقى ما نؤمن به، وما نصل إليه من إبداع، وما نملكه من مبادئ وأخلاق وقِيم، فالانفتاح ليس بالافتضاح، وإذا بُلينا فلنستتر.