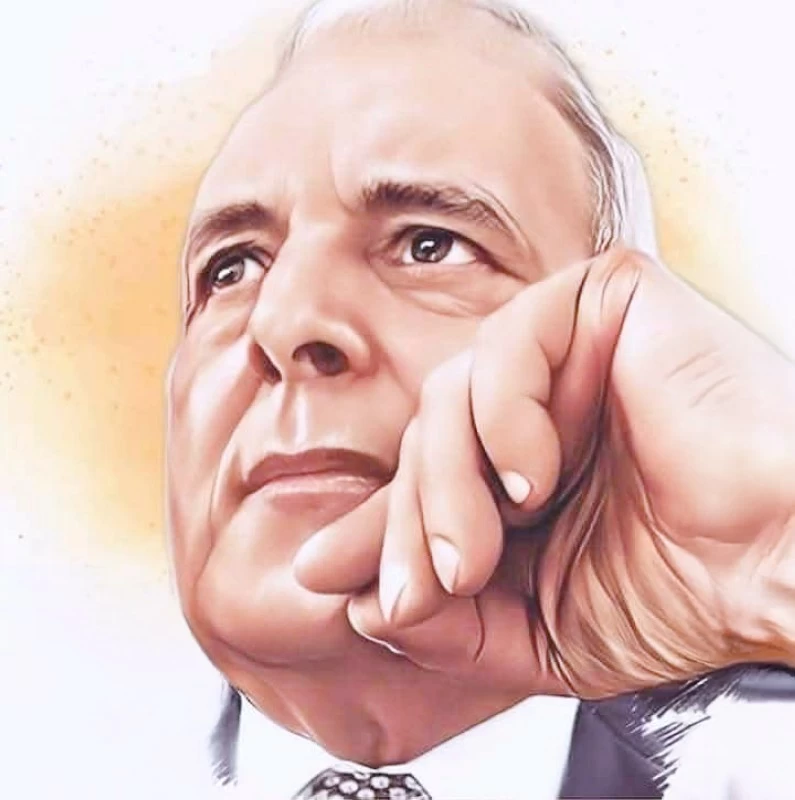عشرات الأخطاء التاريخية حدثت، وتم البناء عليها، وما زالت الكتابات تلوك تلك الأخطاء، وظل كثير من الكتّاب يفند ويحلل، أسباب ونتائج ما أفضت إليه الأخطاء التاريخية.
ولأن الحياة ليس لها رغبة في تعطيل حركتها للأمام، فهي لا تلتفت للخلف مهما كانت جسامة ما حدث، ولأن حياة مثل المقبرة لا ترد ميتاً جاء إليها، هي أيضاً لا تقبل أن تُدفن في مقبرة الماضي.
فما جدوى الكتابة عن ماضٍ لن يستطيع استعادة حيويته؟
وكيف يمكن مجابهة حجة من يقول إن الكتابة عن التاريخ القديم، كمن يريد فلسفة دوران الماء في النافورة!
وكثير ممن يخطو للمستقبل يسقط حجج الباحثين عن تبيان كيف حدث الخطأ التاريخي في زمن ما، فهؤلاء يحملون حجية أن الزمن دفن ما مر به، فلماذا النبش في جثمان قُبر، وقد خلّف ذرية نسيته، وانطلقت إلى الأمام.
أما المتمسكون بالكتابة عن تلك الأخطاء التاريخية يحملون حجية ضرورة إبلاغ الأجيال بما حدث من خطأ جعل الحاضر يظهر على ما هو عليه الآن.
وهي حجية المؤدلجين الذين يرغبون دوماً في إعادة دولاب الأيام إلى نقطة الارتكاز.
فما حدث من خطأ قبل مئات السنوات، لا يصلح الآن تقويمه، فكل الأحداث الزمكانية اجتازت تلك الأزمان، وتم دفع ضريبة الأخطاء، وكذلك دفع ضريبة التصويب.
ولو ضربنا مثالاً بسيطاً لذلك الخطأ التاريخي، كموقعة الجمل، أو صفين، أو انتصار المعتزلة في زمن المأمون، أو معضلة خلق القرآن، أو حكم المتوكل، أو سقوط الخلافة العثمانية، أو تقسيم سايس بيكو، أو سقوط برجي التجارة الدولية في 11 سبتمبر، أو ليلة سقوط بغداد، أو اكتشاف مؤامرات الإخوان أو أي حدث حدث بالأمس، يكون حكم الواقع عليه أن ما حدث أصبح ماضياً، وأن الحاضر سوف يرمم كل الأخطاء لكي يأتي الغد.
فما يحدث اليوم هو الواقع، وأي حدث يحدث ويغير في اليوم يصبح هو المستقبل.
حكمنا على مجريات الأحداث يعتبر من مشاغل اليوم، والأقاويل التي تقال بعد مضي اليوم أصبحت تاريخاً نعيش به غداً.
التصويب هو عجلة ضخمة اسمها الحياة تدرس ما يصادفها لتبدو حكايات الغد.