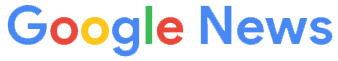يبدو أن هناك حالة من الخمول والاسترخاء أصابت روح الاعتدال، فاستسلم بعض المناوئين للفكر المتطرف للدعاية المتشددة وسلموا لها بأنها «تعبر عن حقيقة الإسلام»، وأنها «الأقرب تمثيلاً للتراث الإسلامي»، وانجروا بكل طواعية إلى حالة الاختطاف الجائرة التي فرضتها الجماعات المتشددة على الإرث الإسلامي.
إنها حالة بارعة من سطوة الفكر المتطرف، ونتاج لبنية التخلف التي أفرزت على مدى عقود صياغة جديدة للتراث، بانتقائية ظالمة، واختصار وابتسار يتلاءمان مع روح التقهقر والجمود التي عمت المنطقة منذ قرون، فغاب الإرث الحضاري المتنوع القديم، وبقي نشطاً من بينه ما يعزز ممارسات التشدد والتطرف. شاع وانتشر بفعل دعاية الحركات المتشددة، وعلى مر الزمان، وتوالي الأيام، سقط بعض المعتدلين أمام سطوة الشائع والمألوف، فظهرت تلك المقولات التي تقول: «داعش تمثل الإسلام»، «داعش بذرة سلفية/ إسلامية»، «داعش نبعت من تراثنا»!.
مقولات تقوم على نظرة مختزلة مختصرة، تنطلق في حكمها من آخر ما وصلت إليه الحالة الإسلامية في ظرفها الزماني من ممارسة وتأصيل وكأن ذلك بمجمله يعبر عن شمول الإرث الإسلامي الممتد عبر مئات السنين. نظرة يعتريها الكسل العلمي، والتعميم المريح، أو ربما التعب من مناكفة الخصم، والتسليم له بتركتنا التراثية كي يعيث باسمها فساداً وإرهاباً وجنوناً.
إنه أمر يدعو للأسى والحزن - كما يقول أمين معلوف في (الهويات القاتلة) - حين ترى من يبدون سعداء للغاية «لأنهم قرروا أن ما يحدث من قبل الإرهابيين هو من طبيعة الإسلام وأن الوضع لن يتغير».
لك أن تتخيل حضارة على مدى قرون تضرب في عمق التاريخ، امتدت على رقعة كبيرة من العالم، وانضوى تحت لوائها العديد من الأمم والأقليات والقوميات والإثنيات الفاعلة حتى اليوم، من الترك والفرس والهنود والبربر، اندمجوا بشكل كبير في حياة الحضارة العربية الإسلامية، وفي فترات واسعة من تاريخها كانوا هم قادتها، والمؤثرين الكبار في مسيرتها، فاختلطت العلوم والمعارف وتطورت، وتنوعت وتعددت المذاهب والاجتهادات والطوائف إلى أعداد لا حصر لها، كلها تنبع من النص الديني وتسعى إلى فهمه وتمثله، وتحقيقه على أرض الواقع، سواء قاربت الصواب أو ابتعدت. فزخرت المكتبة الإسلامية بآلاف الكتب والمؤلفات التي عجت بالتفسيرات الدينية المختلفة، وصل إلينا منها جزء، وفُقدت أجزاء، في حالة من الحراك والجدال العلمي الذي أثرى الحضارة الإسلامية بشكل كبير، وجسد صورة فريدة عن التنوع المذهل الذي عبر بصدق عن التحضر الإسلامي في عصور مجده ورقيه.
بعد هذا كله هل يمكن أن يقال بعد مرور 1400 سنة أن فصيلاً إسلامياً متطرفاً هو المعبر عن حقيقة الإسلام والتراث!
لقد بقي النص الديني واحداً، لكن الاجتهادات والتفسيرات حوله جاءت متعددة مختلفة، وربما متناقضة حتى في المذهب الواحد، وهذا ما يفسر ديمومة النص وحيويته التي أمدته بالبقاء على مر الزمان، حين تغوص في كتب الفقهاء قد تجد التأصيل للمسألة ونقيضها، المذاهب ترد على المذاهب، والأفكار تفند الأفكار، والتراث يناقش التراث، «قد نجد الأدلة مثلاً على إباحة الرق وإدانته، والأدلة على وجوب الديموقراطية أو وجوب الثيوقراطية، إن النص لا يتغير، لكن نظرتنا هي التي تتغير.. النص يؤثر في حقائق العالم من خلال نظرتنا التي تتجدد بالمعاني» (معلوف)، وكما قال الفقهاء: «الأحكام تتغير بتغير الأحوال والأزمان».
لن أتحدث هنا عن روح التسامح والانفتاح التي ميزت الحضارة العربية الإسلامية، والقدرة الفائقة التي ميزتها في استيعاب أكبر قدر من شعوب العالم، والامتزاج مع ثقافتهم وعاداتهم والسماح لهم بالتأثير والتأثر، فكل هذا قد استفاضت كتب التاريخ في الحديث عنه تفصيلاً وتعليلاً وتوضيحاً، لكن نستذكر هنا حجم التنوع والتعدد الفكري الذي أفرزته الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها، حين تنوعت مشارب الناس إلى شيع وأحزاب ومذاهب وتيارات شتى، في بيئة سمحت لكل هذه الفرق أن تنمو وتزدهر وتجد لأفكارها مكاناً ومتسعاً، فهناك المذاهب الفقهية الشهيرة، كمذهب أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجعفر الصادق، والمذاهب الفقهية المندثرة كمذهب الطبري، وأبوسفيان الثوري، والليث بن سعد، وعطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، وابن راهوية، وهناك المذهب الظاهري، والأشعري، والصوفي، إضافة لذلك هناك المعتزلة، والشيعة والخوارج، والمرجئة، الذين انقسموا بدورهم إلى عشرات الفرق والمذاهب المتفرعة، إذ نجد الزيدية والإباضية، والماتريدية، والكلابية، والجعفرية، والشاذلية، والقادرية، والحرورية، والمشائية، وغيرها. هذا عدا الديانات الأخرى التي كانت موجودة ومتعايشة في كنف الحكم الإسلامي كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة وغيرها. عاشت كل هذه المذاهب في جو من حرية الفكر، وسماحة المجتمع، و«لم يصل إلينا أن أحداً تعرض للاضطهاد بسبب أفكاره إلا القدر القليل، وكانت أغلب الاضطهادات التي حدثت سياسية أكثر منها دينية»، كما يقرر ذلك الأستاذ أحمد أمين في مشروعه «فجر الإسلام/ضحى الإسلام/ ظهر الإسلام».
إنك حين تقرأ كتباً مثل «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري، أو «الملل والنحل» للشهرستاني، أو «الفرْق في الفِرق» للبغدادي، سوف ترى مذاهب وأقوالاً لا حصر لها في الإلهيات، وطرائق فهم النص الديني، ما يجعلك تفقد كل حجة في يدك بإمكانها أن تسعفك في حصر الإسلام وتراثه في فرقة أو طائفة واحدة!
لذلك هل سيكون من المنطقي أو الموضوعي حين تتسيد فرقة ما للمشهد الراهن أن نقول عنها بكل سهولة: «إنها المعبر الحقيقي عن تراث الإسلام»!.
إن الحكم على جماعة أو معتقد انطلاقاً من ظروف زمانية محددة سيقود إلى اختلال منهجي وعلمي، حين ترى اليوم واقع الديانة المسيحية قد تصل إلى نتيجة أنها تؤسس للانفتاح والتعايش والتسامح مع الآخر، وتنأى بنفسها عن الحكم والسياسة، لكن حين تعود إلى جذور المسيحية وأزمنتها الأولى، ستنقلب على حكمك بالنفي القاطع، وتجد كماً هائلاً من ممارساتها التي تكرس القتل والتعذيب والنفي والحرق والإبادة ومحاكم التفتيش. هي دورة طبيعية من التخلف، أصابت أوروبا في قرونها الوسيطة، فعم الظلام واستشرى الجهل، وازدهر التطرف الديني، الأمر ذاته يتكرر اليوم حين حط التخلف برحاله في المجتمعات الإسلامية.
من المؤسف حقاً حين ترى بعض المنتمين إلى قيم الاعتدال والانفتاح والتسامح يهربون من تراثهم أو يتنكرون له بعد سطوة المتشددين عليه، ظناً منهم أن هذا هو الشكل الوحيد للتراث، لكن لا الصحوة ولا الحركات الإسلامية، لا داعش ولا القاعدة يمكنها أن تحتكر التراث أو تدعي أنها الممثل الوحيد له، إن التراث الإسلامي أكبر وأشمل وأوسع منهم جميعاً.
الأسس الجوهرية في الحضارة لا تضيع أبداً مهما حل بها من زلازل وأوبئة وجدب، وحروب مخربة، وهجرات مدمرة، «فالحضارات وحدات متصلة في كل أكبر منها وأعظم اسمه التاريخ، فهي مراحل من حياة الإنسانية، نتاج تعاوني لكثير من الشعوب، والطبقات، والأديان، وليس في وسع من يدرسها أن يتعصب لشعب أو مذهب»، - كما يعلق المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت مختتماً المجلد 13 الخاص بالحضارة الإسلامية ضمن موسوعته (قصة الحضارة) -.
إن أي ديانة أو أيديولوجيا، سواء كانت دينية أو بشرية، علمانية أو شيوعية أو قومية، قد تنحرف فتقوم بسفك الدماء والقتل، وقد تصبح رائدة في التسامح والانفتاح، وكل ذلك مرهون بأتباعها وأبنائها، مرهون بتطورهم ورقيهم، أو بارتكاسهم وتخلفهم.
* كاتب وباحث سعودي