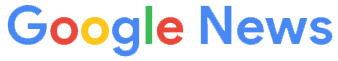يعترف أصدقاء كُثر بما للناقد الكاتب أحمد بوقري من سعة إطلاع وهبته قدرات معرفيّة، ومهارات اتصالية، وثقافة موسوعية، ما عزز حضوره الفكري والإنساني، ولا غرابة عندما ينتقل بوقري من ضفة الناقد إلى مرفأ الكاتب، يعود لعشقه الأزلي (السرد) كونه كاتب قصة مرموقاً، إلا أن المصافحة بسيرة ذاتية مغامرة محسوبة، خصوصاً وهو يمتح من بئره الأولى تحت أفياء ظلال مكة.
لا تخلو الظلال من دلالات حقيقية ومجازية، فالظل متحرّك وانزياحي، يُبدي ويعيد، ويكشف ويخفي؛ ولذا كان العنوان «ظلاً» يحتمي به كاتبنا، من حساسيات ردود أفعال شهود أحياء، لم يعتادوا قراءة أدب الاعتراف الذي يقول ما يقال وما لا يُقال، إلا أنه قول المُحتشم، الذي لا يهبط ببشريته لدرك الشيطنة الرجيمة، ولا يبالغ في الارتقاء بها لملائكية متوهّمة.
في سيرته الذاتية؛ يعبّر بوقري بعفويّة، ويصف الأشياء كما هي دون إصرار مسبق، ولا قصد لاحق، فالجانب التوثيقي لحياة وازنة، وسياقات متزنة، وحياة اجتماعية متوزانة، ينقلنا جميعاً لصالة عرض مرئي، لنشاهد الجدة والأم (روح المكان)، والأب ناثر الذكريات، المثقف التقدمي، والأعمام، وكأنما كل فردٍ من أُسرة بوقري خليج يحمل من مياه الأمطار ما يوسّع مصب نهر الوعي، ويغذّي ذاكرته، ويشرّب عاطفته بأقداح مكيّة، نمير البيئة المُتحررة، من كُل عُقد النقص، والارتياب والتكلّف، فالحياة ترسم ملامح ومسارات الناس وهم يُجارونها ولا يرفضونها.
لم يتبرّم «ظلال مكة» من استدعاء زمن السبعينات والثمانينات بما سنحت به الذكريات وما احتفظت به الذاكرة، وبحسّ مفتون بماضٍ، لن يعود، تطغو «النوستالجيا» على العمل الصادر عن «دار متون» في مئة وأربعين صفحة، والفضاء المكاني لمكة شرّفها الله، بظلال حرمها، وكعبتها، وأحيائها، وأزقتها، وباعتها، ومطوفيها، ورجالها ونسائها، وحجاج البيت الحرام ومعتمريه، يُلقي بالضوء على شخصية الكاتب المتنامية منذ الولادة في بيتٍ مشيّد بالآجر الأحمر ومسقوف بسيقان أشجار عطرية، يحتل ربوةً من جبل أبي قبيس، وروشانه يطلّ على أول بيت وُضع للناس.
كأنما نحن بالقراءة ندخل معه، في منزله الذي لا يزال يسكن روحه، برغم انتقالات الجسد لبيوت ومنازل لم تُفلح في محو عبق المنزل الأول، ولم تنجح في إلغاء شذى الحارة والجارة الأولى، ولم تخرم جدار التفاعلية بين الزمان والمكان والإنسان، في رحلة يومية شاقة شيّقة، وعالم الشهادة لا يُتيح لشغف الطفولة وفضول المراهقة؛ التعرّف على كل شيء، فما خفي أكثر مما أُعلن.
وبرغم شعورنا برغبة كاتبنا الكبيرة في إزاحة الظلال، والجلوس معه، ومع أصداء تلك الأيام تحت الشمس، خصوصاً عندما غدا بيتهم الثاني (العمارة) سكناً للحجاج، فالدائرة الإنسانية والعاطفية اتسعت، وتجاوزت حدود العيب العُرفي، ليغدو القص «الايروتيكي» لبنة من لبنات البناء الدرامي، فالمنزل مراد ومعاد لضيوف تتقاطع غاياتهم، وتختلف لهجاتهم، وأزياؤهم، وأطعمتهم، وأهازيجهم، وعاداتهم، وملاحتهم، فيما يتيح الكاتب لسكان العمارة كامل حريتهم، ويكتفي مع أهله بغرفة على السطوح، ليتحوّل السطوح لمرجعيّة ومسرحاً لمشاعر قاصدي المشاعر ومستضيفيهم.
ليس في العمل أدلجة ولا تسييس، فكما نمت عاطفة الكاتب نما عمله الإبداعي ببساطة وجرأة لا مزايدة معها، وتناغمية خالية من الخجل والمهايطة، فكل ما هو عنصر من عناصر الحياة يقبل الكتابة عنه، خصوصاً المدرسة، بكل ما تعنيه من رهبة، وصياغة وجدان، ومشاكسات، واشتباكات شبه يومية، مروراً بالمكتبة التي غذّت الروح العاشقة بما تحتاجه من أحاسيس ولغة ضرورية؛ لإلقائها في أسماع البدر حين يتجلى.
يضعنا كاتبنا، عبر «ظلال مكة» أمام عالم بأكمله، تمثله أسرة محدودة العدد، واسعة النشاط، رحبة العاطفة، أصيلة القيم، سخيّة العطاء، مهجوسة بالثقافة، بدءاً من الحرم المكي، مروراً بالمذياع، والصحف، والتلفزيون، والعلاقات الاجتماعية، ضمن سياقات متصالحة، مع نفسها، وما حولها، دون تعصّب ولا تعنصر، وهنا سيرة بيضاء تغنينا عن قراءة آلاف السيّر المطليّة بالألوان، والمشوّهة بالمساحيق.
لا تخلو الظلال من دلالات حقيقية ومجازية، فالظل متحرّك وانزياحي، يُبدي ويعيد، ويكشف ويخفي؛ ولذا كان العنوان «ظلاً» يحتمي به كاتبنا، من حساسيات ردود أفعال شهود أحياء، لم يعتادوا قراءة أدب الاعتراف الذي يقول ما يقال وما لا يُقال، إلا أنه قول المُحتشم، الذي لا يهبط ببشريته لدرك الشيطنة الرجيمة، ولا يبالغ في الارتقاء بها لملائكية متوهّمة.
في سيرته الذاتية؛ يعبّر بوقري بعفويّة، ويصف الأشياء كما هي دون إصرار مسبق، ولا قصد لاحق، فالجانب التوثيقي لحياة وازنة، وسياقات متزنة، وحياة اجتماعية متوزانة، ينقلنا جميعاً لصالة عرض مرئي، لنشاهد الجدة والأم (روح المكان)، والأب ناثر الذكريات، المثقف التقدمي، والأعمام، وكأنما كل فردٍ من أُسرة بوقري خليج يحمل من مياه الأمطار ما يوسّع مصب نهر الوعي، ويغذّي ذاكرته، ويشرّب عاطفته بأقداح مكيّة، نمير البيئة المُتحررة، من كُل عُقد النقص، والارتياب والتكلّف، فالحياة ترسم ملامح ومسارات الناس وهم يُجارونها ولا يرفضونها.
لم يتبرّم «ظلال مكة» من استدعاء زمن السبعينات والثمانينات بما سنحت به الذكريات وما احتفظت به الذاكرة، وبحسّ مفتون بماضٍ، لن يعود، تطغو «النوستالجيا» على العمل الصادر عن «دار متون» في مئة وأربعين صفحة، والفضاء المكاني لمكة شرّفها الله، بظلال حرمها، وكعبتها، وأحيائها، وأزقتها، وباعتها، ومطوفيها، ورجالها ونسائها، وحجاج البيت الحرام ومعتمريه، يُلقي بالضوء على شخصية الكاتب المتنامية منذ الولادة في بيتٍ مشيّد بالآجر الأحمر ومسقوف بسيقان أشجار عطرية، يحتل ربوةً من جبل أبي قبيس، وروشانه يطلّ على أول بيت وُضع للناس.
كأنما نحن بالقراءة ندخل معه، في منزله الذي لا يزال يسكن روحه، برغم انتقالات الجسد لبيوت ومنازل لم تُفلح في محو عبق المنزل الأول، ولم تنجح في إلغاء شذى الحارة والجارة الأولى، ولم تخرم جدار التفاعلية بين الزمان والمكان والإنسان، في رحلة يومية شاقة شيّقة، وعالم الشهادة لا يُتيح لشغف الطفولة وفضول المراهقة؛ التعرّف على كل شيء، فما خفي أكثر مما أُعلن.
وبرغم شعورنا برغبة كاتبنا الكبيرة في إزاحة الظلال، والجلوس معه، ومع أصداء تلك الأيام تحت الشمس، خصوصاً عندما غدا بيتهم الثاني (العمارة) سكناً للحجاج، فالدائرة الإنسانية والعاطفية اتسعت، وتجاوزت حدود العيب العُرفي، ليغدو القص «الايروتيكي» لبنة من لبنات البناء الدرامي، فالمنزل مراد ومعاد لضيوف تتقاطع غاياتهم، وتختلف لهجاتهم، وأزياؤهم، وأطعمتهم، وأهازيجهم، وعاداتهم، وملاحتهم، فيما يتيح الكاتب لسكان العمارة كامل حريتهم، ويكتفي مع أهله بغرفة على السطوح، ليتحوّل السطوح لمرجعيّة ومسرحاً لمشاعر قاصدي المشاعر ومستضيفيهم.
ليس في العمل أدلجة ولا تسييس، فكما نمت عاطفة الكاتب نما عمله الإبداعي ببساطة وجرأة لا مزايدة معها، وتناغمية خالية من الخجل والمهايطة، فكل ما هو عنصر من عناصر الحياة يقبل الكتابة عنه، خصوصاً المدرسة، بكل ما تعنيه من رهبة، وصياغة وجدان، ومشاكسات، واشتباكات شبه يومية، مروراً بالمكتبة التي غذّت الروح العاشقة بما تحتاجه من أحاسيس ولغة ضرورية؛ لإلقائها في أسماع البدر حين يتجلى.
يضعنا كاتبنا، عبر «ظلال مكة» أمام عالم بأكمله، تمثله أسرة محدودة العدد، واسعة النشاط، رحبة العاطفة، أصيلة القيم، سخيّة العطاء، مهجوسة بالثقافة، بدءاً من الحرم المكي، مروراً بالمذياع، والصحف، والتلفزيون، والعلاقات الاجتماعية، ضمن سياقات متصالحة، مع نفسها، وما حولها، دون تعصّب ولا تعنصر، وهنا سيرة بيضاء تغنينا عن قراءة آلاف السيّر المطليّة بالألوان، والمشوّهة بالمساحيق.