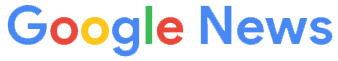«على الكتاب أن يكون الفأس التي نحطم بها البحر المتجمد بداخلنا». (فرانز كافكا)
يتحلى قراء الروايات بقدر من الحكمة يفوق ذلك الذي يملكه أقرانهم من القراء، ويتجلى ما قد يكون امتيازاً منحه إياهم التنقل الدؤوب في عوالمٍ كثيفة الأفكار والرؤى من خلال قدرتهم على استحضار ما قرأوا وما خلصوا إليه لافتراض ما ستواجهون، سيناريوهات نابهة تقفز إلى أذهانهم وانتقال لافت من التفكير إلى التعبير يمكنهم من تجاوز المنزلقات دون لأيٍ أو مشقة.
وحينما يدور الحديث عن الأدب أو عن إحدى الروايات التي ظلت عالقة في أذهانهم فإنهم يتحدثون بتلك الطريقة الآسرة التي تميزهم عمن سواهم، تتدفق الكلمات على ألسنتهم بسلاسة متناهية وتبرز لغتهم المترعة بالسحر وربما أوردوا في سياق حديثهم ما يعرفه الآخرون، لكنه لا يبدو كما قيل من قبل ولذلك يكون وقعه مختلفاً.
هل ثمة سر ما يجعل حديثاً مألوفاً يبدو حاذقاً وخارقاً لمجرد أنه قيل بأسلوب روائي؟
من المرجح أن ليس ثمة ما يمكنه أن يجمع بين مران العقل وإثراء العاطفة وإغناء المخيلة كما هي الروايات، وعدا عن تلكم المزية التي يتفرد بها هذا النوع من الأدب والتي جعلته قادراً على ضبط إيقاعي العقل والعاطفة والمواءمة بينهما وإيجاد التوازن المنشود حيال ما يجب أن نقول ونفعل فإن الرواية في الآن ذاته تستطيع أن تحول كل فعل أو حوار إلى تجربة عاطفية أو مغامرة شيقة وتجعل خوضهما أمراً ماتعاً ومشوقاً وربما تجاوزت ذلك إلى ما يبدو خوارق لا تتأتى لسواها.
قد تبدو هذه مبالغة على نحو ما ولكن ماذا عن ذلك السحر الذي تمنحه الرواية لقرائها؟
في الروايات ثمة ما يمكن وصفه بهالة من العاطفة، هالة أخاذة وخصبة تنبعث عن جوقة الجُمل التي اصطفت إزاء عيني القارئ لتنشد جملةً من المشاعر والحكم تتهادى عبر فضاء اللغة لتستقر في قلبه.
الشعور بتلك الهالة يشبه تحسس شقوق الكتابة التي نقشها صبي على صخرة ما ثم عاد إليها شاباً فأيقظت ذاكرته وأثارت حنينه، ومحاولة تفسيرها تشبه محاولة اقتفاء أثر الأحجية التي تزداد غموضاً، وكلما استعصى حلها ازداد شعوره بأنه خبرها منذ زمن بعيد، ألفة تحصل بينهما لكنها تبقي كل منهما على بعد يسير من الآخر، وبمرور الوقت تصبح المتعة في إعمال العقل وليس في حل الأحجية وفي محاولة الإمساك بهالة الكلمات وليس في القبض عليها، بيد أن عدم الشعور بها كالخثرة الدموية التي تسد الشريان وتحول دون مرور الأكسجين إلى العقل.
إن الأفكار التي تطفو في مخيلة القارئ إبان انغماسه في قراءة رواية ما تبدو مهيبة ونابهة وما ينبت أسفل القشرة الرقيقة لخيالاته سينمو بسرعة ويتمدد إلى ما هو أبعد من المتعة لينال من سبل تفكيره، ومن شعوره بالأشياء من حوله.
ثمة ما سيجعل أفكاره مزدهرة وروحه مزهرة، النافذة المطلة على الزقاق الضيق ستبدو كطريق تؤدي إلى السماء لتلامس زرقتها، العاطفة التي أغمضت عينيها باكراً ستلتقط كوباً من القهوة يعيدها مجدداً إلى حراسة القلب، التلة المجدبة خلف المنزل الريفي ستغدو جادةً تغوص بالمارة، هكذا هو الأمر.
بيد أن ما يبعث الحياة في تلك الرموز المتيبسة التي تدعى الكلمات يتجاوز المهارة في استنفار قدرتها الكامنة على وصف المحسوس والمعقول بدقة ورقة عاليتين، وأعانتها على التموضع قريبا من قلب القارئ، حيث يسمع حفيف عاطفته ويستطيع أن يصغي من خلالها إلى خفقه ويتعدى ذلك إلى ما هو أبعد، كما أن اختراقها للطبقات المتراكمة في روح القارئ وتحقيقها للاتصال العاطفي لن يتأتى دون قدرة القارئ على أن يجعلها تشعر وتفكر ولا قبل أن يمنحها حيزاً تزاول فيه حيلها وبراءتها، وهو أمر قد يبدو مدهشاً وخيالياً إلى حد بعيد لكنه ممكن وإن كان بمستويات يحكمها التفاوت الطبيعي بين متلق وآخر، فكل أمر يتوقف على ما نقتنيه من بصيرة وما ننتقيه لأنفسنا وما نستطيع أن نراه عندما ننظر إلينا تلك النظرة المتأنية التي تبقي أرواحنا متأهبةً، وآملةً ويقظةً وعندما نفعل تستطيع الكلمات أن تطوف حولنا وتفكر وتشعر كنحن فيصار بها إلى خارقة ما.
فإذا ما استطاع نص إبداعي أو حتى عبارة مصقولة على نحو جيد أن تنفذ إلى أرواحنا لتعالج جزءاً من تشوهاتنا السيكولوجية فإن الفضل لا يعود إليها أو إلى كاتبها فحسب، بل إن معظمه يعود إلى قابليتنا على الإصغاء بقلوب منفتحة وقدرتنا على السير بأناة وتودة في أروقة الرواية لنلتقط المعنى في حينه كما يفعل البستاني إزاء الثمار الناضجة، ولذلك فقد اعتاد الكِتاب أن يخرج من الرف متوجساً وقلقا إلى أن يتيقن تلك القابلية، وما إن يفعل حتى يفتح ذراعيه لمعانقة صديقه الجديد فتتسع بقع الضوء الضئيلة وتنفذ من شرفة الروح وتتمدد إلى أن يشعر وإيانا بالدفء يدب في أوصالنا ومن ثم يذهب بخياله ليكشف عما تنفرج له أسارير العقل.
الحقيقة أن الرواية ما انفكت عن كونها الجمل الأمثل والطريقة المثلى التي تصف العاطفة والحدث ببراعة وإتقان، ولا عن كونها الغيمة الماطرة التي يطفئ وبلها ما تشعله الظروف المارقة في أرواحنا، ولا عن كونها الوثيقة التي تحول كل إنسان على هذه الأرض من مجرد رقم إلى قضية تسترعي الانتباه.
قد تساورنا الشكوك حيال قدرة روائي ما على إبهارنا ونحجم عن عبور ذلك الجسر الذي يصل روايته بأرواحنا لأننا نشعر بهشاشته ولأننا في حاجة دائمة إلى السير على أرض صلبة إلا أن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن داخل كل رواية ألق خفي نعجز عن رؤيته وهو يشبه على نحو ما إيجاد مكان متعين لتلك الهالة ومن ثم محاولة القبض عليها.
يتحدث الأمريكي توني ديترليزي فنان الخيال ومؤلف كتب الأطفال عن سحر الرويات بدهشة ويقين، فيصف كيف كان لروايته القصص على مسمع من ابنته التي كانت تعاني الاختلاج الحموي أثراً يشبه المهدئات، ويذكر كيف كان لها أن تبعث في أوصالها شعوراً بالارتياح عقب كل نوبة صرع تهاجمها، كانت القصص تنتشلها من حجرتها المكتظة بالأردية البيضاء والعيون القلقة ورائحة الأمونيوم إلى الغابات الشاسعة بأشجارها السامقة وأعشابها الرطبة لتركض على أعشابها الرخوة محاولةً القبض على الساحرة أو التوقف إزاء جذع شجرة لتكتشف أسفله سراً من أسرارها.
الرواية داخل الأدغال
كيف استطاعت الرواية أن تشق طريقاً داخل الأدغال المتشابكة في رأس الطفلة لتهرب من خلالها بعيداً عن واقعها المؤلم؟
إن لدى الروايات طاقة طليقة العنان تحيل العقل إلى مروج خضراء تقفز فيها الأفكار كالمهار والغزلان، كما أنها تجلب نفحة جديدة ونظرة متفائلة إلى الحياة تأخذ بقلب القارئ بعيداً عن هذا العالم المضطرب فينخفض دوي الانفجارات ويهدأ هلع الأوبئة وتختفي بيانات البورصات لتحل بدلاً عنها موسيقى وسلام وغنى روحي، ففي الرواية منافٍ كثيرة ينتقي القارئ أكثرها بهجة وأوفرها خصوبة بالأفكار ما يعني أنه يصبح منفياً بإرادته إلى حيث تصنع مخيلته عالمه الخاص.
يخبرنا الروائي الأوروغواياني إدواردو غاليانو مؤلف الرواية الشهيرة «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية» إحدى أهم وأروع الروايات التي تحدثت عن تاريخ النهب والاستغلال اللذين تعرضت لهما أمريكا اللاتينية منذ وطأها كوتيز وكولومبس بأحصنتهما وبنادقهما ليُقعدا للاحتلال الأوروبي فيما بعد عن خارقة أخرى، ففي مقالته المعنونة بحياة الكتابة يصف بزهو كيف كان لروايته «كرة القدم في الشمس والظل» التي أعاد من خلالها حشداً ضخماً من الذكريات واللحظات الحاسمة في تاريخ كرة القدم إلى ذاكرة القراء أن تنقذ عضو الكونغرس المكسيكي «فيكتور كوينتانا» بعد أن اختطفه قتلة مأجورون استؤجروا لمعاقبته على كشفه بعض الأعمال القذرة لمتنفذين وكيف أقتادوه إلى مكان ما وأوسعوه ضرباً حتى شارف على الموت وقبل أن يُجهزوا عليه بدأوا نقاشاً حول كرة القدم فما كان منه وهو على بعد ثوانٍ من حتفه إلا أن أدلى برأيه وانبرى يروي لهم قصصاً حفظها من رواية غاليانو استحسنها القتلة فأصغوا إليه باهتمام بالغ وكأنما شعروا أنهم وإياه يقفون في المدرج العتيق لملعب سنتيناريو، وما إن أنهى حديثه حتى حملوا أسلحتهم ومضوا تاركينه حياً.
كان هناك ما يشبه السحر في القصص التي رواها كوينتانا بدأ كالأمل الخفيض وأتسع شيئا فشيئا إلى أن سلب ألبابهم وهذب وحشيتهم وأحال عنفهم إلى دعة.
إن اعتقاداً بخوارق الروايات قد يحدث طنيناً يستوقف حركة العقل لبرهه قبل أن ينطلق ثانيةً لكن الغوص في رواية ما قد يخلق شعوراً حميمياً تجاه ذلك الاعتقاد.
حتى أولئك الذين يعدون خوارق كهذه ضرباً من المبالغة أو خليقة صدفة يؤمنون بأن للروايات تجلياتها داخل أرواحنا وأن ثمة مناطق في الروح تُعنى بما يُقرأ وأن ذلك الانسجام الذي تتخلق من خلاله أمزجة جديدة تطوي ما كان كما لو كانت لفافة تبغ يُخمد دخانها ثورة الغضب فلا يعود كما هو من قبل، هي إحدى الخوارق التي جعلت من قراءة الرواية ترياقاً نتشافى به، و«فأساً تحطم بها البحر المتجمد في داخلنا» كما يقول كافكا.
يتحلى قراء الروايات بقدر من الحكمة يفوق ذلك الذي يملكه أقرانهم من القراء، ويتجلى ما قد يكون امتيازاً منحه إياهم التنقل الدؤوب في عوالمٍ كثيفة الأفكار والرؤى من خلال قدرتهم على استحضار ما قرأوا وما خلصوا إليه لافتراض ما ستواجهون، سيناريوهات نابهة تقفز إلى أذهانهم وانتقال لافت من التفكير إلى التعبير يمكنهم من تجاوز المنزلقات دون لأيٍ أو مشقة.
وحينما يدور الحديث عن الأدب أو عن إحدى الروايات التي ظلت عالقة في أذهانهم فإنهم يتحدثون بتلك الطريقة الآسرة التي تميزهم عمن سواهم، تتدفق الكلمات على ألسنتهم بسلاسة متناهية وتبرز لغتهم المترعة بالسحر وربما أوردوا في سياق حديثهم ما يعرفه الآخرون، لكنه لا يبدو كما قيل من قبل ولذلك يكون وقعه مختلفاً.
هل ثمة سر ما يجعل حديثاً مألوفاً يبدو حاذقاً وخارقاً لمجرد أنه قيل بأسلوب روائي؟
من المرجح أن ليس ثمة ما يمكنه أن يجمع بين مران العقل وإثراء العاطفة وإغناء المخيلة كما هي الروايات، وعدا عن تلكم المزية التي يتفرد بها هذا النوع من الأدب والتي جعلته قادراً على ضبط إيقاعي العقل والعاطفة والمواءمة بينهما وإيجاد التوازن المنشود حيال ما يجب أن نقول ونفعل فإن الرواية في الآن ذاته تستطيع أن تحول كل فعل أو حوار إلى تجربة عاطفية أو مغامرة شيقة وتجعل خوضهما أمراً ماتعاً ومشوقاً وربما تجاوزت ذلك إلى ما يبدو خوارق لا تتأتى لسواها.
قد تبدو هذه مبالغة على نحو ما ولكن ماذا عن ذلك السحر الذي تمنحه الرواية لقرائها؟
في الروايات ثمة ما يمكن وصفه بهالة من العاطفة، هالة أخاذة وخصبة تنبعث عن جوقة الجُمل التي اصطفت إزاء عيني القارئ لتنشد جملةً من المشاعر والحكم تتهادى عبر فضاء اللغة لتستقر في قلبه.
الشعور بتلك الهالة يشبه تحسس شقوق الكتابة التي نقشها صبي على صخرة ما ثم عاد إليها شاباً فأيقظت ذاكرته وأثارت حنينه، ومحاولة تفسيرها تشبه محاولة اقتفاء أثر الأحجية التي تزداد غموضاً، وكلما استعصى حلها ازداد شعوره بأنه خبرها منذ زمن بعيد، ألفة تحصل بينهما لكنها تبقي كل منهما على بعد يسير من الآخر، وبمرور الوقت تصبح المتعة في إعمال العقل وليس في حل الأحجية وفي محاولة الإمساك بهالة الكلمات وليس في القبض عليها، بيد أن عدم الشعور بها كالخثرة الدموية التي تسد الشريان وتحول دون مرور الأكسجين إلى العقل.
إن الأفكار التي تطفو في مخيلة القارئ إبان انغماسه في قراءة رواية ما تبدو مهيبة ونابهة وما ينبت أسفل القشرة الرقيقة لخيالاته سينمو بسرعة ويتمدد إلى ما هو أبعد من المتعة لينال من سبل تفكيره، ومن شعوره بالأشياء من حوله.
ثمة ما سيجعل أفكاره مزدهرة وروحه مزهرة، النافذة المطلة على الزقاق الضيق ستبدو كطريق تؤدي إلى السماء لتلامس زرقتها، العاطفة التي أغمضت عينيها باكراً ستلتقط كوباً من القهوة يعيدها مجدداً إلى حراسة القلب، التلة المجدبة خلف المنزل الريفي ستغدو جادةً تغوص بالمارة، هكذا هو الأمر.
بيد أن ما يبعث الحياة في تلك الرموز المتيبسة التي تدعى الكلمات يتجاوز المهارة في استنفار قدرتها الكامنة على وصف المحسوس والمعقول بدقة ورقة عاليتين، وأعانتها على التموضع قريبا من قلب القارئ، حيث يسمع حفيف عاطفته ويستطيع أن يصغي من خلالها إلى خفقه ويتعدى ذلك إلى ما هو أبعد، كما أن اختراقها للطبقات المتراكمة في روح القارئ وتحقيقها للاتصال العاطفي لن يتأتى دون قدرة القارئ على أن يجعلها تشعر وتفكر ولا قبل أن يمنحها حيزاً تزاول فيه حيلها وبراءتها، وهو أمر قد يبدو مدهشاً وخيالياً إلى حد بعيد لكنه ممكن وإن كان بمستويات يحكمها التفاوت الطبيعي بين متلق وآخر، فكل أمر يتوقف على ما نقتنيه من بصيرة وما ننتقيه لأنفسنا وما نستطيع أن نراه عندما ننظر إلينا تلك النظرة المتأنية التي تبقي أرواحنا متأهبةً، وآملةً ويقظةً وعندما نفعل تستطيع الكلمات أن تطوف حولنا وتفكر وتشعر كنحن فيصار بها إلى خارقة ما.
فإذا ما استطاع نص إبداعي أو حتى عبارة مصقولة على نحو جيد أن تنفذ إلى أرواحنا لتعالج جزءاً من تشوهاتنا السيكولوجية فإن الفضل لا يعود إليها أو إلى كاتبها فحسب، بل إن معظمه يعود إلى قابليتنا على الإصغاء بقلوب منفتحة وقدرتنا على السير بأناة وتودة في أروقة الرواية لنلتقط المعنى في حينه كما يفعل البستاني إزاء الثمار الناضجة، ولذلك فقد اعتاد الكِتاب أن يخرج من الرف متوجساً وقلقا إلى أن يتيقن تلك القابلية، وما إن يفعل حتى يفتح ذراعيه لمعانقة صديقه الجديد فتتسع بقع الضوء الضئيلة وتنفذ من شرفة الروح وتتمدد إلى أن يشعر وإيانا بالدفء يدب في أوصالنا ومن ثم يذهب بخياله ليكشف عما تنفرج له أسارير العقل.
الحقيقة أن الرواية ما انفكت عن كونها الجمل الأمثل والطريقة المثلى التي تصف العاطفة والحدث ببراعة وإتقان، ولا عن كونها الغيمة الماطرة التي يطفئ وبلها ما تشعله الظروف المارقة في أرواحنا، ولا عن كونها الوثيقة التي تحول كل إنسان على هذه الأرض من مجرد رقم إلى قضية تسترعي الانتباه.
قد تساورنا الشكوك حيال قدرة روائي ما على إبهارنا ونحجم عن عبور ذلك الجسر الذي يصل روايته بأرواحنا لأننا نشعر بهشاشته ولأننا في حاجة دائمة إلى السير على أرض صلبة إلا أن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن داخل كل رواية ألق خفي نعجز عن رؤيته وهو يشبه على نحو ما إيجاد مكان متعين لتلك الهالة ومن ثم محاولة القبض عليها.
يتحدث الأمريكي توني ديترليزي فنان الخيال ومؤلف كتب الأطفال عن سحر الرويات بدهشة ويقين، فيصف كيف كان لروايته القصص على مسمع من ابنته التي كانت تعاني الاختلاج الحموي أثراً يشبه المهدئات، ويذكر كيف كان لها أن تبعث في أوصالها شعوراً بالارتياح عقب كل نوبة صرع تهاجمها، كانت القصص تنتشلها من حجرتها المكتظة بالأردية البيضاء والعيون القلقة ورائحة الأمونيوم إلى الغابات الشاسعة بأشجارها السامقة وأعشابها الرطبة لتركض على أعشابها الرخوة محاولةً القبض على الساحرة أو التوقف إزاء جذع شجرة لتكتشف أسفله سراً من أسرارها.
الرواية داخل الأدغال
كيف استطاعت الرواية أن تشق طريقاً داخل الأدغال المتشابكة في رأس الطفلة لتهرب من خلالها بعيداً عن واقعها المؤلم؟
إن لدى الروايات طاقة طليقة العنان تحيل العقل إلى مروج خضراء تقفز فيها الأفكار كالمهار والغزلان، كما أنها تجلب نفحة جديدة ونظرة متفائلة إلى الحياة تأخذ بقلب القارئ بعيداً عن هذا العالم المضطرب فينخفض دوي الانفجارات ويهدأ هلع الأوبئة وتختفي بيانات البورصات لتحل بدلاً عنها موسيقى وسلام وغنى روحي، ففي الرواية منافٍ كثيرة ينتقي القارئ أكثرها بهجة وأوفرها خصوبة بالأفكار ما يعني أنه يصبح منفياً بإرادته إلى حيث تصنع مخيلته عالمه الخاص.
يخبرنا الروائي الأوروغواياني إدواردو غاليانو مؤلف الرواية الشهيرة «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية» إحدى أهم وأروع الروايات التي تحدثت عن تاريخ النهب والاستغلال اللذين تعرضت لهما أمريكا اللاتينية منذ وطأها كوتيز وكولومبس بأحصنتهما وبنادقهما ليُقعدا للاحتلال الأوروبي فيما بعد عن خارقة أخرى، ففي مقالته المعنونة بحياة الكتابة يصف بزهو كيف كان لروايته «كرة القدم في الشمس والظل» التي أعاد من خلالها حشداً ضخماً من الذكريات واللحظات الحاسمة في تاريخ كرة القدم إلى ذاكرة القراء أن تنقذ عضو الكونغرس المكسيكي «فيكتور كوينتانا» بعد أن اختطفه قتلة مأجورون استؤجروا لمعاقبته على كشفه بعض الأعمال القذرة لمتنفذين وكيف أقتادوه إلى مكان ما وأوسعوه ضرباً حتى شارف على الموت وقبل أن يُجهزوا عليه بدأوا نقاشاً حول كرة القدم فما كان منه وهو على بعد ثوانٍ من حتفه إلا أن أدلى برأيه وانبرى يروي لهم قصصاً حفظها من رواية غاليانو استحسنها القتلة فأصغوا إليه باهتمام بالغ وكأنما شعروا أنهم وإياه يقفون في المدرج العتيق لملعب سنتيناريو، وما إن أنهى حديثه حتى حملوا أسلحتهم ومضوا تاركينه حياً.
كان هناك ما يشبه السحر في القصص التي رواها كوينتانا بدأ كالأمل الخفيض وأتسع شيئا فشيئا إلى أن سلب ألبابهم وهذب وحشيتهم وأحال عنفهم إلى دعة.
إن اعتقاداً بخوارق الروايات قد يحدث طنيناً يستوقف حركة العقل لبرهه قبل أن ينطلق ثانيةً لكن الغوص في رواية ما قد يخلق شعوراً حميمياً تجاه ذلك الاعتقاد.
حتى أولئك الذين يعدون خوارق كهذه ضرباً من المبالغة أو خليقة صدفة يؤمنون بأن للروايات تجلياتها داخل أرواحنا وأن ثمة مناطق في الروح تُعنى بما يُقرأ وأن ذلك الانسجام الذي تتخلق من خلاله أمزجة جديدة تطوي ما كان كما لو كانت لفافة تبغ يُخمد دخانها ثورة الغضب فلا يعود كما هو من قبل، هي إحدى الخوارق التي جعلت من قراءة الرواية ترياقاً نتشافى به، و«فأساً تحطم بها البحر المتجمد في داخلنا» كما يقول كافكا.