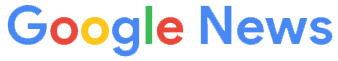ليس كل من يأتي يترك أثراً، ولا كل من يترك أثراً تحتفظ الذاكرة بصورته النقيّة، وعطائه الخلّاق، وفي جازان الإنسان والتاريخ والوعي كان اللقاء الأوّل بالناقد الأكاديمي الدكتور أيمن بكر، وبحسّه المعرفي، وزاده الثقافي، استشعر أهمية العطاء خارج أسوار الجامعة، فنمّى شجيرات طريّة، وتبنى أصواتاً نديّة، وحضر في منتديات المثاقفة، وترك بصمة كفّ كلما زار عاشق جنوب القلب تطلّع لمصافحتها، وهنا حديث ذكريات، واستعادة حقبة لها ما بعدها:
• أين غاب الناقد أيمن بكر؟
•• كانت الفترة الأولى خلال أزمة كورونا صعبة على الجميع، لقد توقفت حركة دوران الكرة الأرضية فجأة بالمعنى المجازي طبعاً، لكنها مثلت لي فرصة كي أعود لبعض مشاريع البحث للتواصل في بنائها. وكانت النتيجة هي كتاب «الطقوسية، السردية، المبالغة: نحو نظرية للشعر العربي الحديث» الذي فاز ضمن الدورة الأولي من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي. غياب الناقد أو الكاتب المهموم بتطوير نفسه هو مقدمة لحضور جديد يا صديقي. ولعلي لا أذيع سرّاً حين أقول إن الأساس عندي هو الغياب، فهو الفعل الأهم لدى أي كاتب أو مبدع، فالغياب هو تخلية الذات لما تحب أن تفعل من تأمل وتحصيل وإنتاج، وإسكات لصخب العالم الذي لم يعد يعني لي سوى التشويش وتضييع الوقت.
• ما حال ثقافتنا العربية؟
•• من الصعب تحليل ثقافاتنا العربية جميعها بصورة تسمح لي أو لغيري بإجابة جامعة مانعة لهذا السؤال. لكن يمكن الاتفاق على معيار واحد يسمح لنا بالنظر إلى تلك الثقافات، وإدراك السبب في الشعور الخفي بوجود أزمة مزمنة شبحية غير قابلة للحل: حال الثقافات العربية يتجلى في حال إنسانها، وهي حال متفاوتة في وضوحها ضمن ما يبدو غالباً على الإنسان العربي من ارتباك وتسطح في الوعي وتمزق روحي داخلي سببه الصراع الخرافي، الذي يشبه الميلاد المتكرر للعنقاء، بين ماضٍ مبجل حد التقديس في مختلف مجالاته، وحاضر متحرك بسرعة مرعبة ضمن قواعد سوق رأسمالية متوحشة، والنتيجة هي شعور ضآلة مخيف يؤدي إلى الاحتماء بأكثر الأفكار نرجسية وعنصرية. نحن ثقافات تستعيد تحديات القرون الوسطى بصورة احترافية أقرب للإدمان أو للعادة العقلية ذاتية الحركة، وهي بذلك تعمل على أن يرث إنسانها أزمات الماضي بهمة وإصرار لا يدانيهما سوى الهمة والإصرار على مقاومة أفكار التحديث والتطوير والعمل على سعادة الإنسان. العيش في الماضي واكتساب مشروعية الفعل من فترات تاريخية لا علاقة لها بتحديات اللحظة الراهنة يربك الوعي بصورة مستمرة، ويحرث الأرض بعمق قادر على ابتلاعنا جميعاً لصالح الفكر المتطرف العنصري العنيف، أي الفكر الكاره للحياة نفسها. يظهر أثر هذا النمط المسيطر على ثقافاتنا العربية في تجليات شبه يومية من التمييز ضد المرأة والتعدي عليها وعلى الأقليات العرقية والدينية، والجهل بما توصلت إليه مسيرة الإنسانية من أفكار تتصل بدولة المواطنة والقانون والتعرف على حدود الحرية وحقوقها في الوقت نفسه، فنحن ثقافات تخشى الحرية وبسبب هذه الخشية العميقة يمارس إنسانها اقتحام حريات الآخرين خشية أن تهتز الخطوط الحمراء التي تكاد تفتك بروحه وإنسانيته. نحن أسرى سرد كبير يمكن أن نطلق عليه اسم «الوجود الآمن بالعودة للماضي».
• متى ستفقد الثقافة دورها؟
•• بحسب التعريف الأنثروبولوجي الواسع لكلمة ثقافة، لا سبيل لأن تفقد دورها، فنحن نتنفس ثقافاتنا بصورة غير واعية، لكن إن كنت تقصد بالثقافة ذلك المنتج الفكري والفني الإبداعي فهو مرتبط بمدى قدرة إرادة الأنساق الاجتماعية والسياسية على دمج المنتج الثقافي الرفيع ضمن برامج عملها. لم أجد فعلاً ثقافياً مؤثراً في التاريخ المرتبط بوجود الدولة -حتى خلال عصر النهضة ومن قبله ازدهار الفلسفات اليونانية- إلا كان مرتبطاً بإرادة الدولة ممثلة في الأنظمة التي تمارس من خلالها الإدارة والسيطرة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً ورغبتها في وجود مثل هذا النشاط المعرفي/الفني الإبداعي. عامة الناس لا يطلبون عادة الفنون والآداب إلا حين تتيسر لهم السبل إليها، إنهم بطبيعة انشغالاتهم وسعيهم المرير لتأمين الوجود، لا يملكون رفاهية البحث الدؤوب عن منتجات الثقافة. وبالطبع لكل قاعدة استثناءات هي ما يمثل قوام النخب غالباً.
• ما أبرز تحديات النخب الثقافية في عصر الميتافيرس؟
•• الإنسان دوماً ينظر إلى ما وراء عالمه، وما وراء قدرات حواسه، نحن دوماً في عصر الميتافيرس، ولكن كل عصر يعبر عن ذلك بحسب إمكانات الوعي المتاحة له والمستوى الذي تطورت إليه المعارف. بالنسبة لعصرنا الحالي أحسب أن أصعب ما يواجه النخب المثقفة، وأعني بها الكتاب والمفكرين والفنانين في مختلف المجالات، أمران مرتبطان بصورة عميقة: الأول هو تجاوز الفلسفات الكبرى، التي تم إنتاجها غالباً خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، في محاولة فهم العالم والإنسان والمجتمع. الأمر الثاني هو إيجاد معادلات تعبير فكري وفني قادرة على مقاومة الخطوط الحمراء الكثيرة التي يبدو أنها تحيط بالمبدعين في كل مكان في الكوكب، وإن كانت خطوطنا العربية الحمراء أكثر عدداً وأشد سماكة.
• بماذا نرمم الخلل الطارئ على البناء الثقافي العربي؟
•• أهو حقّاً خلل طارئ أم أنه خلل مقيم؟ هل نعمل على تطوير الإبداع والمبدعين وحمايتهما أم نتحرك بوعي، أو بلا وعي، للسيطرة عليهما وتحويلهما إلى أداة تحكم وترويج للقوى الاجتماعية المختلفة؟ أحسب أن تجربة الإنسانية في بقاع مختلفة من العالم تعطينا أجوبة شافية لمثل هذه الأسئلة عن ترميم الخلل وتطوير الثقافات والمجتمعات. المطلوب فقط هو إرادة ثقافية/ سياسية لصناعة الفرق والتحرك بثقافات المجتمعات العربية نحو الأمام، واللحاق بركب الحضارات الإنسانية التي تجاوزت المشكلات البدائية للوجود، وهو ما بدأت بعض ثقافاتنا العربية فعلاً بالتحرك نحوه في العقد الأخير. بصورة أوضح؛ لا يمكن إصلاح ثقافة أو مجتمع من دون توسيع مساحات الحرية المحمية بدولة القانون، وكذلك لا يمكن تحريك ثقافاتنا الراكدة من دون بحث عن المواهب الحقيقية في مختلف المجالات، وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية الشابة، ثم تولي هذه المواهب بالرعاية والحماية والحرية. أود أيضاً الإشارة إلى ضرورة الوعي بنسبية رؤانا وتصوراتنا عن العالم، وتكريس تعليم يصلنا بالثقافات الأخرى، ولا يعزلنا عنها. إن الصورة النمطية للعربي في العالم، التي تجعلنا نبدو ككائنات أسطورية آتية من عمق التاريخ ليست مسؤولية من يكره ثقافاتنا ويود أن تبقى في مساحة المستهلك فحسب، بل إننا نشارك في رسمها بإصرار ساذج. أما الخطوات التنفيذية لتجسيد تلك الأفكار على أرض الواقع فهي موجودة يعرفها الخبراء في كل مجال.
• هل تسببت سيولة الثقافة في حجب الناقد؟
•• يبدو أن التطور السريع لمجالات المعرفة يدفع بالملايين كل يوم إلى دائرة الجهل والتخلف عن تلك الحركة. ظني أن مسألة السيولة التي نستشعرها والتي فصّل (زيجمونت باومان) الكلام حولها هي حالة عالمية سببها الرئيس هو توحش السوق الرأسمالي، ثم ثورة الاتصالات وما نتج عنها من وسائل تواصل جماهيرية واسعة النطاق تسمح بارتفاع أصوات الملايين من قليلي النضج بصورة تشبه الصراخ الجماعي. نحن بحاجة لأمرين متلازمين فيما أظن، أولاً: تعليم متطور جدّاً وواسع النطاق كي يستطيع ملايين الراغبين في الكلام أن يشعروا بوزن ما يقولون، وثانياً تطوير آليات الفهم والتحليل (أي آليات النقد) للخطاب الثقافي في مجالات العلوم الإنسانية تحديداً.
• ما سبب غياب الدراسات النقدية الموازية للنتاج الإبداعي؟
•• الدراسات النقدية الحقيقية المعمقة موجودة لكنها نادرة ويجب أن تكون نادرة. لا يجب الاستماع لشكوى كثير من المبدعين الشباب وبعض الكتاب الكبار عن غياب النقد، فهم دون أن يشعروا يدفعون بالحالة الفكرية/ النقدية نحو مزيد من التسطح والتسرع. النقد العميق المبدع موجود لكنه صعب وبطيء في التشكل، لأنه قائم على الفلسفة، ويتطلب إنتاج خطاب فكري/ إبداعي موازٍ للنصوص وليس شارحاً أو مُقَيِّما لها، وهما أمران مرهقان جداً خصوصاً في ثقافات تعادي الفلسفة وتستخف بالفنون والآداب. نهم المبدع للتقدير المستمر يسهم في إغلاق الأفق أمام الدراسات النقدية المعمقة الهادئة. وفي ظل انفجار الخطابات التي تدعي الشعر والسرد والنقد بصورة نيئة عبر وسائل التواصل صارت الأمور أكثر تشوشاً وصعوبة أمام الناقد الساعي لتقديم الجديد العميق، الأعمال كثيرة ووسائل النشر لم تعد تقوم بعمليات فرز لما تنشر، تحول النشر إلى تجارة لا يتقدمها معيار الجودة غالباً، بل يتقدمها معيار السوق: اسم المؤلف.. جنسيته.. احتمالات الفوز بالجوائز.. النقد الحقيقي شحيح ويجب أن يكون كذلك.
• كيف تقرأ ظاهرة تحوّل أفراد المجتمع إلى كتبة؟
•• هذا جزء رئيس من تشوش الصورة في الثقافات الإنسانية كلها، وفي ثقافاتنا العربية بصورة أكبر، فتحول الناس كلهم إلى كتّاب هو تعبير عن فوران متصل للجهل والاستخفاف بمهنة الكتابة، وهو أمر يدعو للأسف حقا؛ إذ كيف تقنع الناس بأن الكتابة مهنة لها أصول صعبة تشكلت عبر تاريخ طويل للأنواع الأدبية والفكرية؟ وكيف تقنعهم بأن صناعة آلة التفكير والتأثير فيها أصعب وأدق وأكثر حساسية من المهن التي تتطلب معارف طبيعية معملية. الكارثة أن كل من يتكلم اللغة يظن أن ما ينطق مهم ويستحق أن يسمعه أو يقرأه الناس جميعاً، إنه قانون الفوضى وغياب المعايير اللذين يؤسس لهما الجهل كما أشرت.
• مِنْ أين جاءت عبارة (ناقد شنطة)؟.. وما سبب ظهورها؟
•• أصل التعبير هو «تاجر شنطة» ويطلق على البائع الجوال الباحث عمن يشتري بضاعته الرخيصة غالباً، إنها بضاعة خفيفة يمكن وضعها في شنطة محمولة على الكتف، فهي إذن أشياء لا يمكن بأي حال أن تكون أساسية في حياتنا، لكنها طريفة وتشبع نهماً ساذجاً للعب. ما سبق هو تحديداً ما يتصف به «ناقد الشنطة»؛ إنه تاجر يحمل في جعبته أدوات نقدية بسيطة مكرورة أشبه باللعب البلاستيكية الرخيصة التي تعمل بآلية واحدة قد تدهشنا لدقائق ثم لا تجد مستقراً لها سوى سلة مهملات اسمها «النسيان». ناقد الشنطة يداعب افتقاد المبدع العربي للتقدير، ورغبته في تطوير تجربته الإبداعية عبر تحقيق مزيد من الفهم المعمق لها. والناقد من هذا النوع يمكنه أن يمنح المبدعين ذلك بصورة موهومة قصيرة الأمد. وبالطبع يتحرك ناقد الشنطة ببضاعته هذه نحو أي مكان يستقبلها ويعطيها أهمية.
• هل يحابي الناقد العربي الكُتّاب الخليجيين بحكم عمله في بلدانهم؟
•• دعنا نتأمل المسألة من جوانب مختلفة: أولاً الناقد القابل للتحوّل إلى ناقد شنطة لن يجد غضاضة في المحاباة وتوطيد مكانته بصورة زائفة مسطحة في المكان من باب توطيد المصالح المادية المباشرة، هذا نمط موجود طبعاً، لكن غياب المعايير النقدية وتلهف المبدعين لتلقي من يتكلم عن تجاربهم وإن بصورة سطحية، هو ما يهيئ التربة لهذا النمط من النقاد المجاملين ليوجد ويزدهر. من زاوية أخرى؛ يبدو أن تسلط فكرة المجاملة للكتاب الخليجيين على المشهد تهدر الاهتمام بتجارب كثير من المبدعين الخليجيين المهمين، وذلك لأن كثيراً من النقاد الجادين سيحجمون عن تناول تلك التجارب تجنباً لشبهة النفاق.
• مَن هو الكاتب أو الشاعر الذي راهنت عليه ولم تخسر رهانك؟
•• هناك عدد كبير من الشعراء الذين رأيت تجاربهم منذ تعرفت عليها مثل عملة ذهبية لا يمكن لمن يراهن عليها أن يخسر مثل محمد حبيبي ومؤمن سمير وأحمد الملا ونادي حافظ وعبدالرحمن موكلي وإبراهيم زولي ومحمد توفيق وأسامة بدر وزكي الصدير وآخرين.
• لمن سلّمت رايتك في جازان؟
•• إن كنت حقّاً ممن يحملون راية تستحق أن ترتفع فرايتي يحملها الطلاب في كل مكان أذهب إليه، وأنا أفخر بطلابي في جازان، فقد كانوا من أرقى الطلاب وأكثرهم جدية، وقد نبغ عدد منهم في مجالات الشعر والنقد والإعلام بعد ذلك، وبعضهم لم يزل على اتصال بي. أما راية النقد فجازان ترفع رايات حتى من قبل وجودي فيها، وتتمثل في إنتاج الناقد المهم حسن حجاب الحازمي وجبريل سبعي وسمير جابر وغيرهم من الباحثين المهمين.
• ما أبرز مشاريعك الآنية والمستقبلية؟
•• أعمل الآن على كتاب حول التجربة المعرفية لطه حسين، وفي الوقت نفسه أحاول الانتهاء من كتابة روايتي الثانية. بعد ذلك سأختفي مرة أخرى لمدة عامين تقريباً للانتهاء من بحث أظنه من أهم ما سأقدم في حياتي.
• أين غاب الناقد أيمن بكر؟
•• كانت الفترة الأولى خلال أزمة كورونا صعبة على الجميع، لقد توقفت حركة دوران الكرة الأرضية فجأة بالمعنى المجازي طبعاً، لكنها مثلت لي فرصة كي أعود لبعض مشاريع البحث للتواصل في بنائها. وكانت النتيجة هي كتاب «الطقوسية، السردية، المبالغة: نحو نظرية للشعر العربي الحديث» الذي فاز ضمن الدورة الأولي من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي. غياب الناقد أو الكاتب المهموم بتطوير نفسه هو مقدمة لحضور جديد يا صديقي. ولعلي لا أذيع سرّاً حين أقول إن الأساس عندي هو الغياب، فهو الفعل الأهم لدى أي كاتب أو مبدع، فالغياب هو تخلية الذات لما تحب أن تفعل من تأمل وتحصيل وإنتاج، وإسكات لصخب العالم الذي لم يعد يعني لي سوى التشويش وتضييع الوقت.
• ما حال ثقافتنا العربية؟
•• من الصعب تحليل ثقافاتنا العربية جميعها بصورة تسمح لي أو لغيري بإجابة جامعة مانعة لهذا السؤال. لكن يمكن الاتفاق على معيار واحد يسمح لنا بالنظر إلى تلك الثقافات، وإدراك السبب في الشعور الخفي بوجود أزمة مزمنة شبحية غير قابلة للحل: حال الثقافات العربية يتجلى في حال إنسانها، وهي حال متفاوتة في وضوحها ضمن ما يبدو غالباً على الإنسان العربي من ارتباك وتسطح في الوعي وتمزق روحي داخلي سببه الصراع الخرافي، الذي يشبه الميلاد المتكرر للعنقاء، بين ماضٍ مبجل حد التقديس في مختلف مجالاته، وحاضر متحرك بسرعة مرعبة ضمن قواعد سوق رأسمالية متوحشة، والنتيجة هي شعور ضآلة مخيف يؤدي إلى الاحتماء بأكثر الأفكار نرجسية وعنصرية. نحن ثقافات تستعيد تحديات القرون الوسطى بصورة احترافية أقرب للإدمان أو للعادة العقلية ذاتية الحركة، وهي بذلك تعمل على أن يرث إنسانها أزمات الماضي بهمة وإصرار لا يدانيهما سوى الهمة والإصرار على مقاومة أفكار التحديث والتطوير والعمل على سعادة الإنسان. العيش في الماضي واكتساب مشروعية الفعل من فترات تاريخية لا علاقة لها بتحديات اللحظة الراهنة يربك الوعي بصورة مستمرة، ويحرث الأرض بعمق قادر على ابتلاعنا جميعاً لصالح الفكر المتطرف العنصري العنيف، أي الفكر الكاره للحياة نفسها. يظهر أثر هذا النمط المسيطر على ثقافاتنا العربية في تجليات شبه يومية من التمييز ضد المرأة والتعدي عليها وعلى الأقليات العرقية والدينية، والجهل بما توصلت إليه مسيرة الإنسانية من أفكار تتصل بدولة المواطنة والقانون والتعرف على حدود الحرية وحقوقها في الوقت نفسه، فنحن ثقافات تخشى الحرية وبسبب هذه الخشية العميقة يمارس إنسانها اقتحام حريات الآخرين خشية أن تهتز الخطوط الحمراء التي تكاد تفتك بروحه وإنسانيته. نحن أسرى سرد كبير يمكن أن نطلق عليه اسم «الوجود الآمن بالعودة للماضي».
• متى ستفقد الثقافة دورها؟
•• بحسب التعريف الأنثروبولوجي الواسع لكلمة ثقافة، لا سبيل لأن تفقد دورها، فنحن نتنفس ثقافاتنا بصورة غير واعية، لكن إن كنت تقصد بالثقافة ذلك المنتج الفكري والفني الإبداعي فهو مرتبط بمدى قدرة إرادة الأنساق الاجتماعية والسياسية على دمج المنتج الثقافي الرفيع ضمن برامج عملها. لم أجد فعلاً ثقافياً مؤثراً في التاريخ المرتبط بوجود الدولة -حتى خلال عصر النهضة ومن قبله ازدهار الفلسفات اليونانية- إلا كان مرتبطاً بإرادة الدولة ممثلة في الأنظمة التي تمارس من خلالها الإدارة والسيطرة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً ورغبتها في وجود مثل هذا النشاط المعرفي/الفني الإبداعي. عامة الناس لا يطلبون عادة الفنون والآداب إلا حين تتيسر لهم السبل إليها، إنهم بطبيعة انشغالاتهم وسعيهم المرير لتأمين الوجود، لا يملكون رفاهية البحث الدؤوب عن منتجات الثقافة. وبالطبع لكل قاعدة استثناءات هي ما يمثل قوام النخب غالباً.
• ما أبرز تحديات النخب الثقافية في عصر الميتافيرس؟
•• الإنسان دوماً ينظر إلى ما وراء عالمه، وما وراء قدرات حواسه، نحن دوماً في عصر الميتافيرس، ولكن كل عصر يعبر عن ذلك بحسب إمكانات الوعي المتاحة له والمستوى الذي تطورت إليه المعارف. بالنسبة لعصرنا الحالي أحسب أن أصعب ما يواجه النخب المثقفة، وأعني بها الكتاب والمفكرين والفنانين في مختلف المجالات، أمران مرتبطان بصورة عميقة: الأول هو تجاوز الفلسفات الكبرى، التي تم إنتاجها غالباً خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، في محاولة فهم العالم والإنسان والمجتمع. الأمر الثاني هو إيجاد معادلات تعبير فكري وفني قادرة على مقاومة الخطوط الحمراء الكثيرة التي يبدو أنها تحيط بالمبدعين في كل مكان في الكوكب، وإن كانت خطوطنا العربية الحمراء أكثر عدداً وأشد سماكة.
• بماذا نرمم الخلل الطارئ على البناء الثقافي العربي؟
•• أهو حقّاً خلل طارئ أم أنه خلل مقيم؟ هل نعمل على تطوير الإبداع والمبدعين وحمايتهما أم نتحرك بوعي، أو بلا وعي، للسيطرة عليهما وتحويلهما إلى أداة تحكم وترويج للقوى الاجتماعية المختلفة؟ أحسب أن تجربة الإنسانية في بقاع مختلفة من العالم تعطينا أجوبة شافية لمثل هذه الأسئلة عن ترميم الخلل وتطوير الثقافات والمجتمعات. المطلوب فقط هو إرادة ثقافية/ سياسية لصناعة الفرق والتحرك بثقافات المجتمعات العربية نحو الأمام، واللحاق بركب الحضارات الإنسانية التي تجاوزت المشكلات البدائية للوجود، وهو ما بدأت بعض ثقافاتنا العربية فعلاً بالتحرك نحوه في العقد الأخير. بصورة أوضح؛ لا يمكن إصلاح ثقافة أو مجتمع من دون توسيع مساحات الحرية المحمية بدولة القانون، وكذلك لا يمكن تحريك ثقافاتنا الراكدة من دون بحث عن المواهب الحقيقية في مختلف المجالات، وما أكثرها في مجتمعاتنا العربية الشابة، ثم تولي هذه المواهب بالرعاية والحماية والحرية. أود أيضاً الإشارة إلى ضرورة الوعي بنسبية رؤانا وتصوراتنا عن العالم، وتكريس تعليم يصلنا بالثقافات الأخرى، ولا يعزلنا عنها. إن الصورة النمطية للعربي في العالم، التي تجعلنا نبدو ككائنات أسطورية آتية من عمق التاريخ ليست مسؤولية من يكره ثقافاتنا ويود أن تبقى في مساحة المستهلك فحسب، بل إننا نشارك في رسمها بإصرار ساذج. أما الخطوات التنفيذية لتجسيد تلك الأفكار على أرض الواقع فهي موجودة يعرفها الخبراء في كل مجال.
• هل تسببت سيولة الثقافة في حجب الناقد؟
•• يبدو أن التطور السريع لمجالات المعرفة يدفع بالملايين كل يوم إلى دائرة الجهل والتخلف عن تلك الحركة. ظني أن مسألة السيولة التي نستشعرها والتي فصّل (زيجمونت باومان) الكلام حولها هي حالة عالمية سببها الرئيس هو توحش السوق الرأسمالي، ثم ثورة الاتصالات وما نتج عنها من وسائل تواصل جماهيرية واسعة النطاق تسمح بارتفاع أصوات الملايين من قليلي النضج بصورة تشبه الصراخ الجماعي. نحن بحاجة لأمرين متلازمين فيما أظن، أولاً: تعليم متطور جدّاً وواسع النطاق كي يستطيع ملايين الراغبين في الكلام أن يشعروا بوزن ما يقولون، وثانياً تطوير آليات الفهم والتحليل (أي آليات النقد) للخطاب الثقافي في مجالات العلوم الإنسانية تحديداً.
• ما سبب غياب الدراسات النقدية الموازية للنتاج الإبداعي؟
•• الدراسات النقدية الحقيقية المعمقة موجودة لكنها نادرة ويجب أن تكون نادرة. لا يجب الاستماع لشكوى كثير من المبدعين الشباب وبعض الكتاب الكبار عن غياب النقد، فهم دون أن يشعروا يدفعون بالحالة الفكرية/ النقدية نحو مزيد من التسطح والتسرع. النقد العميق المبدع موجود لكنه صعب وبطيء في التشكل، لأنه قائم على الفلسفة، ويتطلب إنتاج خطاب فكري/ إبداعي موازٍ للنصوص وليس شارحاً أو مُقَيِّما لها، وهما أمران مرهقان جداً خصوصاً في ثقافات تعادي الفلسفة وتستخف بالفنون والآداب. نهم المبدع للتقدير المستمر يسهم في إغلاق الأفق أمام الدراسات النقدية المعمقة الهادئة. وفي ظل انفجار الخطابات التي تدعي الشعر والسرد والنقد بصورة نيئة عبر وسائل التواصل صارت الأمور أكثر تشوشاً وصعوبة أمام الناقد الساعي لتقديم الجديد العميق، الأعمال كثيرة ووسائل النشر لم تعد تقوم بعمليات فرز لما تنشر، تحول النشر إلى تجارة لا يتقدمها معيار الجودة غالباً، بل يتقدمها معيار السوق: اسم المؤلف.. جنسيته.. احتمالات الفوز بالجوائز.. النقد الحقيقي شحيح ويجب أن يكون كذلك.
• كيف تقرأ ظاهرة تحوّل أفراد المجتمع إلى كتبة؟
•• هذا جزء رئيس من تشوش الصورة في الثقافات الإنسانية كلها، وفي ثقافاتنا العربية بصورة أكبر، فتحول الناس كلهم إلى كتّاب هو تعبير عن فوران متصل للجهل والاستخفاف بمهنة الكتابة، وهو أمر يدعو للأسف حقا؛ إذ كيف تقنع الناس بأن الكتابة مهنة لها أصول صعبة تشكلت عبر تاريخ طويل للأنواع الأدبية والفكرية؟ وكيف تقنعهم بأن صناعة آلة التفكير والتأثير فيها أصعب وأدق وأكثر حساسية من المهن التي تتطلب معارف طبيعية معملية. الكارثة أن كل من يتكلم اللغة يظن أن ما ينطق مهم ويستحق أن يسمعه أو يقرأه الناس جميعاً، إنه قانون الفوضى وغياب المعايير اللذين يؤسس لهما الجهل كما أشرت.
• مِنْ أين جاءت عبارة (ناقد شنطة)؟.. وما سبب ظهورها؟
•• أصل التعبير هو «تاجر شنطة» ويطلق على البائع الجوال الباحث عمن يشتري بضاعته الرخيصة غالباً، إنها بضاعة خفيفة يمكن وضعها في شنطة محمولة على الكتف، فهي إذن أشياء لا يمكن بأي حال أن تكون أساسية في حياتنا، لكنها طريفة وتشبع نهماً ساذجاً للعب. ما سبق هو تحديداً ما يتصف به «ناقد الشنطة»؛ إنه تاجر يحمل في جعبته أدوات نقدية بسيطة مكرورة أشبه باللعب البلاستيكية الرخيصة التي تعمل بآلية واحدة قد تدهشنا لدقائق ثم لا تجد مستقراً لها سوى سلة مهملات اسمها «النسيان». ناقد الشنطة يداعب افتقاد المبدع العربي للتقدير، ورغبته في تطوير تجربته الإبداعية عبر تحقيق مزيد من الفهم المعمق لها. والناقد من هذا النوع يمكنه أن يمنح المبدعين ذلك بصورة موهومة قصيرة الأمد. وبالطبع يتحرك ناقد الشنطة ببضاعته هذه نحو أي مكان يستقبلها ويعطيها أهمية.
• هل يحابي الناقد العربي الكُتّاب الخليجيين بحكم عمله في بلدانهم؟
•• دعنا نتأمل المسألة من جوانب مختلفة: أولاً الناقد القابل للتحوّل إلى ناقد شنطة لن يجد غضاضة في المحاباة وتوطيد مكانته بصورة زائفة مسطحة في المكان من باب توطيد المصالح المادية المباشرة، هذا نمط موجود طبعاً، لكن غياب المعايير النقدية وتلهف المبدعين لتلقي من يتكلم عن تجاربهم وإن بصورة سطحية، هو ما يهيئ التربة لهذا النمط من النقاد المجاملين ليوجد ويزدهر. من زاوية أخرى؛ يبدو أن تسلط فكرة المجاملة للكتاب الخليجيين على المشهد تهدر الاهتمام بتجارب كثير من المبدعين الخليجيين المهمين، وذلك لأن كثيراً من النقاد الجادين سيحجمون عن تناول تلك التجارب تجنباً لشبهة النفاق.
• مَن هو الكاتب أو الشاعر الذي راهنت عليه ولم تخسر رهانك؟
•• هناك عدد كبير من الشعراء الذين رأيت تجاربهم منذ تعرفت عليها مثل عملة ذهبية لا يمكن لمن يراهن عليها أن يخسر مثل محمد حبيبي ومؤمن سمير وأحمد الملا ونادي حافظ وعبدالرحمن موكلي وإبراهيم زولي ومحمد توفيق وأسامة بدر وزكي الصدير وآخرين.
• لمن سلّمت رايتك في جازان؟
•• إن كنت حقّاً ممن يحملون راية تستحق أن ترتفع فرايتي يحملها الطلاب في كل مكان أذهب إليه، وأنا أفخر بطلابي في جازان، فقد كانوا من أرقى الطلاب وأكثرهم جدية، وقد نبغ عدد منهم في مجالات الشعر والنقد والإعلام بعد ذلك، وبعضهم لم يزل على اتصال بي. أما راية النقد فجازان ترفع رايات حتى من قبل وجودي فيها، وتتمثل في إنتاج الناقد المهم حسن حجاب الحازمي وجبريل سبعي وسمير جابر وغيرهم من الباحثين المهمين.
• ما أبرز مشاريعك الآنية والمستقبلية؟
•• أعمل الآن على كتاب حول التجربة المعرفية لطه حسين، وفي الوقت نفسه أحاول الانتهاء من كتابة روايتي الثانية. بعد ذلك سأختفي مرة أخرى لمدة عامين تقريباً للانتهاء من بحث أظنه من أهم ما سأقدم في حياتي.