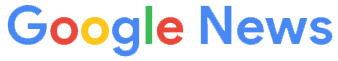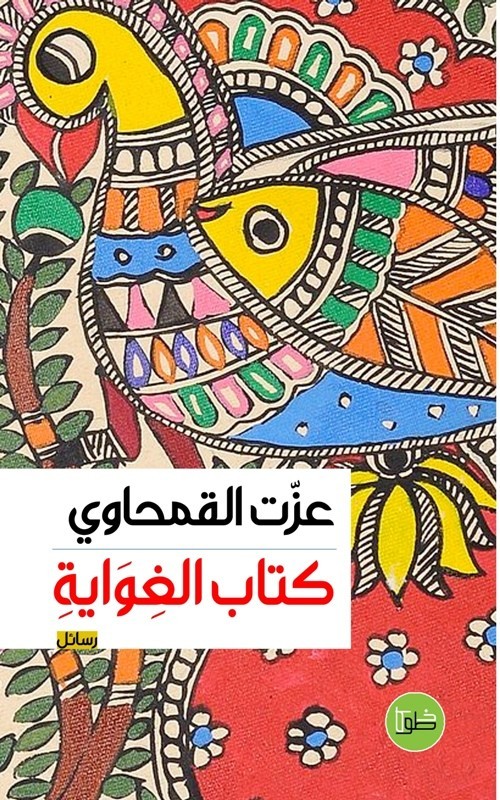

حاولنا في هذا الحوار أن نخرج قليلاً عن المألوف، فأشركنا ناقداً أدبياً، وكاتباً للرواية، وقارئاً أيضاً في هذه الأسئلة التي كان ضيفها الكاتب والروائي العربي عزت القمحاوي.
ما يختلف في هذا الحوار أننا أمام كاتب وروائي متجدّد، له آراؤه الجريئة في الرواية، والكتابة بشكل خاص، والصحافة؛ باعتباره واحداً من أبنائها لسنوات طويلة.
لدينا الكثير من الآراء التي قاربها هذا الحوار، وليس من الإنصاف اختصارها في مقدّمة لا تغني عن المتن، فإلى نصّ الحوار:
• دعنا نبدأ من الرواية العربية.. كيف تراها اليوم؟
•• الرواية هي الفن الذي يجب ألا نقلق بشأنه؛ لأنها قادرة على التجدد دائماً، تستوعب الكثير من الاقتراحات في الشكل، كما تقبل تضمين فنون أخرى بداخلها؛ الشعر مثلاً. وفي هذه اللحظة العربية تتجاور أجيالا عدة، في تدرجات عمرية. لدينا من تبقى من جيل الستينات أطال الله أعمارهم، إلى أحدث شاب يكتب الرواية الآن. أحرص هنا على عدم استخدام مصطلح الجيل إلا بحساب؛ حيث يجب أن يكون تعبيراً عن ذائقة واحدة تنتج أدباً متقارب الملامح، والكتابة مشروع فردي بالأساس، وحتى ما يبدأ جماعياً يجب أن ينتهي إلى الفردية. كسبت الرواية كذلك عدداً من الشعراء تحولوا إليها. لدينا كثرة من الكتاب والروايات، إذاً، لكن ليس أكثر مما يلزم قراء العربية كما يقول البعض عندما يريد الإشارة إلى حالة من استسهال الرواية في بعض الأحيان، وهذه ليست بالمشكلة الكبيرة، فحتى الروايات الخفيفة تجعل قضية القراءة مطروحة في المجتمع.
لا نكتب الرواية أكثر من غيرنا، لكن عدد الروايات يبدو كبيراً قياساً إلى ألوان أخرى من الإبداع، وقياساً إلى الفكر، وأظن أن ما يجب أن يقلقنا هو ندرة الأنواع الأخرى وخصوصاً الفكرية التي تعاني من القلة ومن عدم التوازن ما بين حقول المعرفة المختلفة من فلسفة واجتماع وسياسة وعلم نفس وكتب التفكير العابرة للنوع الثقافي؛ أي التي تجمع بين الأنثربولوجي والنفسي والاجتماعي وهكذا. تنقصنا الكتب التي تهتم بالظواهر الإعلامية بوصفها جزءاً من الحياة السياسية والثقافية.
مشكلة الرواية في الحقيقة أنها مدعوة لتجاوز الأب المؤسس، ومع كل الاحترام للبدايات المبكرة للرواية، فإن كاتباً وحيداً هو نجيب محفوظ صنع بمفرده من خلال تتابع وتنوع مراحل إنتاجه تاريخاً خاصاً للرواية العربية قطع به مراحل تطور الرواية الأوروبية الحديثة التي قطعتها في خمسة قرون.
• ولكن، هناك من يرى نجيب محفوظ السدّ الذي حال دون تجديد الرواية في الأدب العربي الحديث؟
•• هذا الادعاء ليس له ما يبرره من حيث المبدأ، فالأدب العربي ليس شقة غرفتين وصالة احتفظ محفوظ بمفتاحها. لا أحد بوسعه أن يغلق باباً لنفسه. ومن المفترض أن أي كاتب في أي مكان بالعالم ينافس كل ما وصله من الكتابة الجيدة عبر التاريخ وفي مختلف الثقافات، وليس نجيب محفوظ فحسب.
ومن حيث التجربة؛ فالزمن هو الناقد الذي لا يخطئ في تقييم الأدب. نشهد الآن عودة إلى روايات نجيب محفوظ بشكل يفوق حضورها أثناء حياته، بينما اختفت نصوص تالية له بمجرد أن توقف أصحابها عن الركض لتثبيتها عبر حضورهم الشخصي وعلاقاتهم مع النقاد والميديا.
لا أشك أبداً في أن رهان نجيب محفوظ كان على الزمن، ولا أشك في أنه كسب الرهان. كانت معركته مع نفسه، وعندما تعود إلى أحاديثه تجده يبجل الجميع، ويثني على كتّاب أقل منه يحبون الفخر، وكانوا أكثر منه شهرة في زمانهم. وفي الوقت ذاته لم يلتفت إلى من حاولوا التقليل من شأن إبداعه ولم يزعجه التجاهل لوقت طويل. كان مثل عدَّاء المسافات الطويلة عينه على نقطة الوصول آخر المضمار.
• ماذا عن علاقتك الخاصة بأدب نجيب محفوظ ؟
•• علاقتي بكتابة نجيب محفوظ علاقة متطورة؛ لسببين: الأول يكمن في أدبية النص المحفوظي. والأدبية تعني تعدد طبقات النص، بحيث يحصل كل قارئ على مستوى من المعنى يناسب ثقافته، كما يحصل القارئ الواحد على معانٍ متجددة بالقراءات المتعددة للرواية الواحدة. هذا يعني أن السبب الثاني لتطور علاقتي بمحفوظ يرجع إلى تقدم وعيي به من قراءة لأخرى.
في البداية وصلني مستوى من مستويات الفهم والتفاعل، وعندما فاز بنوبل نشأ عندي سؤال من مقارنة جماهيريته بجماهيرية ماركيز. حصل الكاتب الكولومبي الأشهر على جائزة نوبل عام ١٩٨٢ وكان معروفاً على المستوى الدولي بشكل كبير، وساهمت الجائزة في مضاعفة جماهيريته، وعندما حصل نجيب محفوظ على الجائزة المرموقة، لفت الانتباه بالطبع إلى الأدب العربي كله، لكنه لم يصل إلى جماهيرية ماركيز.
هناك أسباب تنبع من ظروف لغتيّ الكاتبين؛ فالإسبانية لغة أوروبية، تدين لها الثقافة العالمية بسرفانتيس وصفّ طويل من الكتاب والشعراء قبل ماركيز، بخلاف العربية التي لا يتذكرها الغرب إلا من خلال ألف ليلة وليلة. لكن هناك ما يخصني شخصياً، إذ صار الفرق بين النجومية والقيمة واضحاً في ذهني بأكثر مما كان.
وعبر تأمل الكاتبين صرت أكثر انحيازاً لنجيب محفوظ. وفي زعمي أن ماركيز كاتب حار، يستخدم الكثير من التوابل في جملته، ويستخدم أسماء التفضيل المطلق: أجمل امرأة في العالم أجمل رجل غريق في العالم، وهكذا.
لا أقرأ الإسبانية لأفهم الفروق اللغوية بين رواياته، وهذه مسألة جوهرية، لكنني بالطبع أحس لغة نجيب محفوظ، وأعرف أنها لا تكون اللغة ذاتها في كل الأعمال، حيث تكون جزءاً من البناء يتناغم مع شخصيات وعالم كل رواية. وبهذا الصوت الخفيض يذهب محفوظ أبعد من ماركيز في الأسئلة حول الوجود والعدم وطبيعة الإنسان. والآن أراه واحداً من كتَّاب الإنسانية الكبار، يرتبط مباشرة مع عظماء مثل دوستويفسكي.
• تعددت أوجه التصنيف لكتابك الأخير «غرفة المسافرين» فهل يشغلك تجنيس النصّ الأدبي وأنت تكتب؟
•• غرفة المسافرين لديه الطموح ليكون كل هذا، وإلى أي حد تحقق هذا الطموح؟ لست المخول بالإجابة، بل القراء والقراء المهرة «النقاد». أما عن سؤالك إن كان التصنيف يشغلني؟ فجوابي: نعم ولا.
في البداية لا يشغلني التصنيف، لأن كل تجربة تختار نوعها الأفضل للتعبير عنها دون إرادة أو توجيه كبير مني. حيث لا ينفصل الشكل عن المعنى في الأدب، وكل معنى يختار الشكل الذي سيستريح فيه.
ولكن عندما أشرع في الكتابة لا بد من الوفاء للنوع الذي اخترته، وإلا ستصبح الأمور فوضى. السلطة تطغى أحياناً لكن اختفاءها مخيف، وأنا لا أريد لسلطة النقد أن تسقط بالكامل. النوع العابر للأجناس مسيرة في كتابتي بدأتها بـ«الأيك» عام ٢٠٠٢ بمجرد أن أكتب النص الأول فيه يتأسس الشكل، ولا بد للوفاء لهذا الشكل الذي كان اعتباطياً منذ لحظة. على أية حال أستمتع بكتابتي دائماً، وأنسجم مع شروط اللعبة في كل كتاب، وأمنحه كل قلبي كأنه الأول والأخير.
• لماذا اختلف قراؤك إذاً على تصنيف هذا الكتاب تحديداً؟
•• لا أعتقد أن «غرفة المسافرين» كتابي الأول الذي اختلف القراء حول تصنيفه، لكنه نال انتباهاً أكبر وانفتح على شركاء جدد، تبناه قراء مختلفون ربما. ومؤكد أنه حظي بدار نشر ممتازة، هو كتابي الثالث من «الدار المصرية اللبنانية» على التوالي، وهناك ربما تطور محمود في ظاهرة القراءة. الأيك مثلاً قوبل بحفاوة كبيرة في حين صدوره، وقد صدر في سلسلة «كتاب الهلال» وكانت طبعتها من عدة آلاف، وكنت وقتها أصغر مؤلف في تاريخ السلسلة منذ إضافتها لإصدارات دار الهلال العريقة عام ١٩٥٢. ولديَّ كذلك كل الرضا عن استقبال «كتاب الغواية» و«العار من الضفتين» وكتاب البورتريهات «ذهب وزجاج». لكن هذه المسيرة مع النص العابر للأجناس أثمرت أخيراً انتباهاً أكثر مع «غرفة المسافرين» دون أن تقل الحيرة النقدية تجاه هذا النوع.
لكنني أشعر بالغبطة لارتباط نصي بالذائقة الشبابية، وأعتبر نفسي نجوت من التقادم، وعليّ أن أواصل الانتباه لما أفعل.
• الاحتيال على القارئ، كيف يكون؟
•• دعنا نستخدم «اللعب» ذات المدلول الأفضل، حيث أصرُّ على أن الكتابة لعبة يلزمها اثنان. إن شئت هي كالحب. لا تكتمل الكتابة إلا بوجود قارئ، بل إن وجودها الحقيقي يبدأ مع أول قارئ يتلقاها ويتفاعل معها. الكثير من علاقات الحب تفشل في حالتين:عندما لا يعود لدى الحبيب شيء نجهله وعندما يظل لغزاً كاملاً، وكذلك العلاقة بين القارئ والكاتب لا يمكن أن تستمر عندما لا يكون لدى الكاتب ما يخفيه أو عندما يكون لديه ما يستغلق على القارئ بالمطلق.
لا بد من أن يكون النص قادراً على كسر أفق التلقي، وعندما يغلق الكاتب باباً، يتوجب عليه أن يمنح القارئ حزمة مفاتيح، وأن يكون بعضها قادراً على الفتح.
• ترجمة النصوص الأدبية إلى اللغات الأجنبية يراها بعض النقاد ظاهرة مرضيّة ترعرعت في الأوساط الأدبية العربية، هل الترجمة تعطي مشروعية للقيمة الأدبية لتلك النصوص؟
•• أعتقد أنني مع هؤلاء النقاد. القارئ الأجنبي ليس أفضل من قارئنا. الترجمة شيء جيد بوصفها إضافة للعدد الإجمالي للقراء. ويجب أن يؤرقنا عدد القراء إجمالاً؛ فرواية توزع عشرة آلاف نسخة في العربية لا بد أن تحقق رضا أكبر مما تحققه رواية توزع ألف نسخة في العربية وبضع مئات في بضع لغات. لدينا مشكلة حقيقية في القراءة. متكلمو العربية فوق 450 مليون نسمة، وتوزيع الكتب لا يتناسب أبداً مع هذا العدد، حيث يدور توزيع الروايات حول الألفي نسخة. حتى روايات «الأكثر مبيعاً» على المستوى العربي تدور حول العشرة آلاف بينما يوزع الكتاب الرصين هذا الرقم في لغة كالدانماركية التي لا يتكلمها أكثر من 5 ملايين.
ومع ذلك، فأنا أميل إلى تجاهل انخفاض معدل القراءة العربي، لكي أسأل نفسي عما ينقص نصي. في النهاية سباق الكاتب يجب أن يكون مع نفسه. وعليه أن يكون واعياً بالمتحقق في النصوص السابقة عليه والنصوص التي تُكتب حوله.
• عملت في الصحافة طويلاً، فماذا تغير في صحافة اليوم عن الأمس؟
•• ليس الكثير، وهذا بيت الداء وأصل المشكلة. منذ عقدين ونصف وجدت الصحافة نفسها في سباق مع وسائط جديدة مثل قنوات التليفزيون الفضائية وشبكة الإنترنت بتطبيقاتها المتعددة من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تنشر الخبر لحظة تحريره، بينما تحتاج الصحيفة إلى نحو ١٢ ساعة من الإعداد قبل الطبع. الحصان مصمم على إكمال السباق مع الصاروخ!
لكن للحصان جمالياته ومتعته. أنا أرى أن الصحافة الورقية قادرة على الحياة لكن في مضمار آخر. المادة المنشورة على الورق أعلى مصداقية؛ توحي بأن كاتب هذه الكلمة مستعد للوقوف خلفها والدفاع عنها، بعكس المنشور في المواقع الإلكترونية فهو يوحي بالهشاشة وسهولة المحو. الوصفة التي جربتها الصحف في اللغات الأخرى وبعض صحفنا العربية وإن بمعدل أقل هي الاتجاه إلى التحقيق الاستقصائي المعمق والقصة الإنسانية المطولة التي تقدم متعة القراءة إلى جانب وظيفتها في الإخبار. هذا يعني أن الصحافة يجب أن تختلف عن صحافة الأمس وتتشابه إلى صحافة أمس الأول. في النصف الأول من القرن العشرين كانت قصيدة الشعر تحتل مكان المقال الافتتاحي في صدر الصحيفة، وكان ثلث الصفحة الأولى من صحيفة «السياسة الأسبوعية» مخصصاً لباب عنوانه «في المرآة» يكتبه كبار الأدباء وهو عبارة عن بورتريه أدبي لشخصية، والكثير من هذه البورتريهات كان ساخراً. بعد الحرب العالمية الثانية تسلمت أمريكا قيادة العالم، وبدأت مدرستها الإخبارية في الانتشار، وهي في الحقيقة مدرسة تمارس التجهيل، حيث يركض القارئ من خبر إلى خبر، بحيث لا تستقر قضية لأكثر من يوم.
• اختلف كتّاب ونقّاد حول كتاب «المتن المجهول» لسيد محمود، وبالتحديد على أنّ محمود درويش صناعة مصرية، فيما كانت لك وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع، ما هي؟
•• كتبت مقالاً في جريدة «الشرق الأوسط» حول الكتاب، وهو كتاب شديد العذوبة، استطاع فيه سيد محمود أن يقدم سردية متماسكة لقصة محمود درويش في مصر، وينقل المناخ السياسي والثقافي مصرياً وعربياً ودولياً. وسبق أن احتفيت بكتاب محمد شعير «سيرة الرواية المحرمة» عن رواية أولاد حارتنا. الصحافة مهنتي وأغار عليها كما أغار على الأدب ومن هذه الزاوية تأتي حفاوتي بالكتابة الاستقصائية التي أرى أنها قادرة على تجديد شباب الصحافة.
أما عن جملة سيد محمود: «درويش صناعة مصرية» فهي مانشيت صحفي، يؤخذ في هذا الإطار، ونحن الصحفيين نميل أحياناً إلى بعض المبالغة، لكن في الأمر بعض الحقيقة. كان لدي صديق درَّس عاماً في كلية الإعلام وصرنا صديقين، هو الراحل وجدي زيد أستاذ الأدب الإنجليزي، وكان يردد على مسامعي كثيراً أن شكسبير صناعة دولة، وكان يعود فيشرح أنه يعني أن للاهتمام المتواصل بشكسبير دوره في الإبقاء عليه حياً، بخلاف دانتي مثلاً.
لا شك أن وقوف دولة بكل آلتها الثقافية والسياسية وراء مبدع يساهم كثيراً، بشرط أن يكون مبدعاً حقيقياً ولا يستنيم للدلال، ونحن نذكر مقال محمود درويش في تلك الحقبة: ارحمونا من هذا الحب القاسي. لقد كان في ذلك الوقت مشروع مبدع كبير يريد أن يحاسب على شعره لا أن نجامله لأنه يمثل قضية عادلة.
وقد لاحظت أن جدل الإنترنت ذهب في مكان آخر. هناك اتهام عربي جاهز للمصريين بالشوفينية الثقافية، وهو اتهام غير حقيقي بالمناسبة. ربما يلاحظ البعض أن المصريين يتابعون بقية العرب بصورة أقل، لكن هذا يرجع إلى اتساع الساحة المصرية، بحيث ينتهي العام قبل أن يتمكن القارئ من ملاحقة الكتب القريبة من يده، مسألة قرب وبعد وليس مسألة تعالٍ، كما أن هناك فجوة ضخمة بين سعر الكتاب المنتج في مصر وسعر المنتج خارجها.
• ماذا يعني لك السفر؟
•• هو فرصة للعيش الكثيف، وفرصة لانعتاق الروح من أثقال حقيقية أو متوهمة تكبلها لأنه يحقق لنا الانقطاع عن روتين كل يوم ومشاهد كل يوم في أماكن عيشنا الأصلية. لم أجرب السفر إلى النجوم وخبرة انعدام الجاذبية. هل يظل الإنسان في ذلك الظرف مقيداً إلى مشكلاته؟ أعتقد أن هذا غير ممكن، قياساً على ما جرَّبته في سفرياتي على الأرض. هناك تخفف من الثقل في السفر، وأظن أن المستوحدين والخجولين هم أحوج الناس إلى هذه الخفة التي يمنحها السفر.
• كيف يمكن للإنسان غير القادر على السفر في المكان أن يرحل في الزمان؟
•• سؤالك هذا هو أحد الأسباب التي أعطت «غرفة المسافرين» شكله. من جهة كونه سفراً في المدن والكتب في الوقت ذاته. غير القادر على السفر إلى مدينة يحبها يمكنه أن يسافر إليها من خلال كتاب، الباحث عن العبرة في الانتقال الجغرافي يجدها في كتاب كذلك. والعكس صحيح كذلك، فالسفر إلى أماكن مختلفة هو عيش حيوات مختلفة بما يضاعف أعمارنا المحدودة. السفر والقراءة يعمقان العيش، وحبذا لو امتلك الإنسان القدرة عليهما معاً.
• ماذا عن العزلة في حياة الأديب عزت القمحاوي؟
•• منذ أيام تهاتفت مع صديقة وسألتها الأسئلة المعتادة عن الأحوال، وردت بالجواب المعتاد منذ بداية كورونا، قالت: «كالعادة قاعدة مع نفسي» فقلت لها إذاً لست وحيدة، المشكلة إذا تركتك نفسك ونامت وقتها ستصبحين وحيدة. بعيداً عن المزاح، لن يعرف نفسه من لا يختلي بها. وأعتقد أن كل المبدعين فيهم مرض وموهبة العزلة بالميلاد، حتى الصاخبين أو من يبدون صاخبين مثل هيمنجواي. العزلة مطلب تحتاجه الكتابة، ويقدر عليه من يولد به. أتذكر أنني كنت دائماً طفلاً منعزلاً، وألاحظ أنني أعود من اللقاءات العامة -على ندرتها- بأقل عدد من أرقام التليفون. أحب الكثير من الناس، ولو كانت لدي قدرة على تلبية هذا الحب بالتواصل، ربما كنت أحظى بحياة أسعد، لكن حياة العزلة أوسع وأكثر أمناً.
• هل بالفعل، أفلت عزت القمحاوي من فخ البدايات المرتبكة؟
•• هناك عيوب للبدايات لا يمكن لأحد أن ينجو منها. وقد كان الراحل الكبير سيد حامد النسَّاج أول من احتفى بمجموعتي القصصية الأولى «حدث في بلاد التراب والطين» وأشار في مقال له، إلى سلامة اللغة معتبراً أن هذه القصص لا تبدو كتابة أولى لصاحبها. لم يزل هناك محبون للمجموعة الأولى، لكن سلامة وربما «اكتمال اللغة» الذي أشار إليه د.النسَّاج هو مصدر العيب، وأنني أفلتُ من فخ البدايات المرتبكة إلى فخ البدايات المحكومة جيداً.
أعتقد أن طموح الاكتمال يوقع البدايات في عيوب تشبه عيوب الارتباك. كنت في ذلك الوقت أريد أن أكون مرئياً، ألا يعيب عليَّ أحدهم، بعد ذلك استرحت لمفهوم اللعب أكثر، والحرص على أن تشبه اللغة عالمها، لا أن تكون كاملة. لا مجال للثرثرة في لغة عالم تحكمه الأوامر في رواية «الحارس» لكن التكرار سيكون جزءاً من الحماسة الطفولية في رواية «ما رآه سامي يعقوب» فسامي يحب البشر والأشياء أو يكرهها جداً جداً، وهكذا.
• وكيف تكون الكتابة لعباً؟
•• أنت تطلب مني أن أصف إحساساً. عندما أكون مستمتعاً أعرف أنه لعب، وعندما تبدأ المعاناة أعرف أنني انتقلت من مربع اللعب إلى مربع الشغل. وهذا يخيفني ويجعلني أتوقف لحين استئناف العذوبة أو الانصراف كلياً عن إكمال النص. أتصور أن اللعب في الكتابة هو ترك مساحات للعشوائية والصدفة، والسخرية. أرى أن السخرية هي أصل الفنتازيا والخيال الجامح. والعكس صحيح كذلك.
الكاريكاتير، عمل انتقادي ساخر، لكنه فانتازي كذلك. الطريقة التي يبالغ بها رسَّام الكاريكاتير في تكبير أنف كبير أوجعل فم صغير بالغ الصغر ينتج في النهاية ملامح ساخرة لشخص نعرفه في الواقع، لكن الرسم يجعله فنتازياً، فليس هناك شخص في الواقع وجهه مجرد أنف، أو فمه لا يتسع سوى لقشة امتصاص العصير!
• هناك من يرى أن السخرية والحكمة تلازمان عزت القمحاوي في كتابته، هل هاتان صفتان مطلوبتان في الكتابة الإبداعية؟
•• السخرية والحكمة طموحي، وأن يتحقق منهما شيء فهذا يسعدني. أحب النكتة، وأحب من يلقيها بشكل جيد؛ هي فن من فنون التأليف والأداء. والنكتة هي الطموح الذي يمكن أن تتمناه الكتابة قصيدة كانت أو قصة أو رواية، من حيث إحكام وتضافر الشكل والمعنى. هي وجهة نظر وراءها ذكاء وخفة روح تحتاجها الكتابة بالطبع.
• هل ما تكتبه مخطط مسبقاً؟
•• لا كتابة يمكن أن تأتي من غير مثير أو متغير في الواقع، والكاتب يستجيب لهذا الحراك. ولا أعني بالواقع الارتباط بالحادث العارض حولنا، بل أعني شرط وجودنا نفسه. محدودية عمرنا هي نفسها واقع يدفع الإنسان على محاولة ترك ما يطيل ذكره في الحياة، ولو عبر إنجاب طفل.
وأن ينجذب أحدنا ليكون كاتباً فهذه خطة بحد ذاتها، وستولد في نفسه أسئلة تفجرها جملة أو حدث صغير أو لحظة تأمل، بعد ذلك تكبر الفكرة لتصبح موضوعاً هو بمثابة روح لا بد أن تحل في جسد لكي تكون مرئية، وهي تتعرف على شكلها، وتدفع الكاتب إلى اختيار الشكل، بنوع من الحدس وليس القرار. لا أخطط الكتابة لكن أتصور بشكل تقريبي شكلها وحجمها، وقد يخرج التنفيذ مختلفاً لهذا التصور.
• وهل ترى فيما تكتب بناء غير مسبوق في الكتابة المصرية والعربية كما يقول بعض المعجبين بما تكتب؟
•• عندما يرى الكاتب ذلك يكون قد كتب شهادة وفاته بنفسه. العلم يمكن أن تحكمه ذروة واحدة ويمكن للعالم أن يتوصل إلى اكتشاف لم يسبقه إليه غيره، في الأدب متسع لتجاور الجميل، وليس هناك جديد لنصل إليه ونكتشفه لكن المتعة في الرحلة، ويمكن لكل كاتب جديد أن يطمح إلى صحبة حسنة مع القارئ في رحلة ممتعة. الشيء الوحيد الأكيد عندي أنني لا أسرق وقتاً من كتاب أكتبه، ولا أترك نصاً من يدي إلا بعد أن أستنفد جهدي وأستنفد كل قدراتي على الإضافة.
• الناقد الدكتور عبدالدائم السلامي يسأل عمّا تطلبه الرواية من قارئها؟
•• للناقد أن يطلب من القارئ، فهو القاضي بين النص والقارئ. والدكتور عبدالدائم السلامي عالج هذا الأمر في كتابه النابه «النص المُعنَّف» لكن الكاتب لا يطلب من القارئ لأن الزبون على حق. (أضحك طبعاً، لأن الزبونية أحد الضغوط الواقعة على الأدب الآن).
في الحقيقة أن امتلاك القارئ لمعرفة جيدة بالمجاز والاهتمام الجيد بما يقرأه يجعله يستمتع أكثر ويستفيد أكثر من اللعبة. نصوص نجيب محفوظ قرأتها السينما من السطح، وهناك الكثير من القراء قرأوها واستمتعوا، لكنهم مثل من يذهب إلى النهر ليغترف منه بدلو مثقوب، عندما يصل إلى نهاية الرواية سيجد في يده دلواً غير ملآن. بمران القراءة المستمر، وقبل ذلك بالتعليم الجيد يستطيع القارئ أن يسد ثقوب دلوه ويقرأ «الحرافيش» بوصفها أسئلة حول الوجود والعدم، حول القوة والحق وحول جوهر السلطة والحرية.
• الروائي السعودي طاهر الزهراني يسأل عن تصوّرك للأسلوب الخاصّ؟
•• أعتقد أن الأسلوب جزء من تكوين الكاتب ونتيجة لهذا التكوين، نتيجة غير إرادية في الأغلب ناتجة عن قراءاته السابقة وتفضيلاته الجمالية وتكوينه الخِلقي والنفسي حتى؛ فأثر كف البصر بادٍ في أسلوب طه حسين الإيقاعي، لغته صوتية مصقولة، فالأذن أقدر على الفرز من العين، في المقابل نجد أسلوب العقاد متغطرساً كشخصيته يتحرى الجامد من الكلمات. لا ينجو كاتب الرواية من هذه الآثار التي تطبع أسلوبه، لكن داخل السمات العامة لا بد أن يجتهد لكي تكون لديه أساليب وليس أسلوباً واحداً، بحيث تتناغم اللغة مع عالم كل رواية. هكذا نرى في «الحرافيش» بداية أقرب إلى الشعر، تحيل إلى صوت القدر في الشكل الملحمي، بينما في «اللص والكلاب» نجد بداية إخبارية تناسب عالم نوفيلا صغيرة تتابع سجيناً خرج للتو، ويريد الانتقام ممن غدروا به.
• قارئ يسأل عن التاريخ الذي تراه علماً لا يُنتفع به؟
•• هذه ملاحظة أبديها دائماً عندما أرى أن البشر يريدون لمس النار مرة بعد مرة ليعرفوا أنها تحرق. الحضارات تقوم وتزدهر وتضمحل بالطريقة نفسها دون أن تستفيد واحدة مما جرى لسابقاتها عندما فسدت أو استرخت، ولا يستفيد حاكم ممن سبقه. في مجال الأدب كذلك أرى التاريخ علماً لا يُنتفع به؛ فالبعض يكرس وقته للعلاقات العامة وليس لتحسين نصه. وهذا سعي يحقق بعض المنافع العابرة مهما كانت كبيرة، وبعد ذلك يأتي حكم الزمن الذي لا يخطئ؛ فيُبقي على نجيب محفوظ ويتجاهل من كانوا نجوماً في عصره.
• قارئ آخر يسأل عن الكاتب الذي يلجأ للتجريب عندما يعجز عن الكتابة بشكل جيد؟
•• هذا السؤال يكاد يكون حكماً على كاتب محدد في ذهن السائل أو لعله يرى نماذج من الألغاز وليس نموذجاً واحداً جعله يسأل هذا السؤال. الصيغة توحي كذلك بأن التجريب المقصود هو تجريب في الشكل. وأنا هنا ألتزم بجوابي على سؤال سابق. ليفعل الكاتب ما يريد على أن يضع في يد القارئ مفاتيح للنص. الإنسان عدو ما يجهل، ولا يمكن لأحد أن يستسيغ الطلاسم.
لكن التجريب ضرورة ومسؤولية وليس باباً للهروب. والكاتب الذي لا يجرب وليست لديه مراحل تختلف باختلاف الزمن ليس كاتباً كبيراً، بل صنايعي يعرف طريقاً آمناً ويسير فيه. كما أن التجريب ليس في الشكل فحسب، هناك التجريب في الشخصية وفي اختبار الأفكار. ظل نجيب محفوظ يختبر فكرته عن الوجود في عدد من الروايات: أولاد حارتنا، الطريق، وغيرها، وبلغت المعالجة ذروة إحكامها في «الحرافيش» كذلك كان المُعلم الأكبر دوستويفسكي يجرب بناء شخصية من عمل إلى عمل، كأنه عالم نووي يجرب تحفيز الذرات، ليرى ما سيحصل عليه في كل مرة، وأحياناً ما يكون السابق أكثر كمالاً من اللاحق، لكن قلق الفنان جعله يحاول مجدداً رسم صورة القديس من خلال «أليوشا» في رواية «الأخوة كارامازوف» بعد أن رسم «الأمير مشكين» في «الأبله» كما نرى الشخص المتأرجح على الحافة بين استعذاب الإهانة وإيلام الآخرين في عدد من الشخصيات، وتصل التجربة في النهاية إلى مارميلادوف والد سونيا الغارق في ضعفه ووضاعته في «الجريمة والعقاب» ثم نراها في الوالد فيودور كارمازوف الغارق في الضعة والاستقواء.
ما يختلف في هذا الحوار أننا أمام كاتب وروائي متجدّد، له آراؤه الجريئة في الرواية، والكتابة بشكل خاص، والصحافة؛ باعتباره واحداً من أبنائها لسنوات طويلة.
لدينا الكثير من الآراء التي قاربها هذا الحوار، وليس من الإنصاف اختصارها في مقدّمة لا تغني عن المتن، فإلى نصّ الحوار:
• دعنا نبدأ من الرواية العربية.. كيف تراها اليوم؟
•• الرواية هي الفن الذي يجب ألا نقلق بشأنه؛ لأنها قادرة على التجدد دائماً، تستوعب الكثير من الاقتراحات في الشكل، كما تقبل تضمين فنون أخرى بداخلها؛ الشعر مثلاً. وفي هذه اللحظة العربية تتجاور أجيالا عدة، في تدرجات عمرية. لدينا من تبقى من جيل الستينات أطال الله أعمارهم، إلى أحدث شاب يكتب الرواية الآن. أحرص هنا على عدم استخدام مصطلح الجيل إلا بحساب؛ حيث يجب أن يكون تعبيراً عن ذائقة واحدة تنتج أدباً متقارب الملامح، والكتابة مشروع فردي بالأساس، وحتى ما يبدأ جماعياً يجب أن ينتهي إلى الفردية. كسبت الرواية كذلك عدداً من الشعراء تحولوا إليها. لدينا كثرة من الكتاب والروايات، إذاً، لكن ليس أكثر مما يلزم قراء العربية كما يقول البعض عندما يريد الإشارة إلى حالة من استسهال الرواية في بعض الأحيان، وهذه ليست بالمشكلة الكبيرة، فحتى الروايات الخفيفة تجعل قضية القراءة مطروحة في المجتمع.
لا نكتب الرواية أكثر من غيرنا، لكن عدد الروايات يبدو كبيراً قياساً إلى ألوان أخرى من الإبداع، وقياساً إلى الفكر، وأظن أن ما يجب أن يقلقنا هو ندرة الأنواع الأخرى وخصوصاً الفكرية التي تعاني من القلة ومن عدم التوازن ما بين حقول المعرفة المختلفة من فلسفة واجتماع وسياسة وعلم نفس وكتب التفكير العابرة للنوع الثقافي؛ أي التي تجمع بين الأنثربولوجي والنفسي والاجتماعي وهكذا. تنقصنا الكتب التي تهتم بالظواهر الإعلامية بوصفها جزءاً من الحياة السياسية والثقافية.
مشكلة الرواية في الحقيقة أنها مدعوة لتجاوز الأب المؤسس، ومع كل الاحترام للبدايات المبكرة للرواية، فإن كاتباً وحيداً هو نجيب محفوظ صنع بمفرده من خلال تتابع وتنوع مراحل إنتاجه تاريخاً خاصاً للرواية العربية قطع به مراحل تطور الرواية الأوروبية الحديثة التي قطعتها في خمسة قرون.
• ولكن، هناك من يرى نجيب محفوظ السدّ الذي حال دون تجديد الرواية في الأدب العربي الحديث؟
•• هذا الادعاء ليس له ما يبرره من حيث المبدأ، فالأدب العربي ليس شقة غرفتين وصالة احتفظ محفوظ بمفتاحها. لا أحد بوسعه أن يغلق باباً لنفسه. ومن المفترض أن أي كاتب في أي مكان بالعالم ينافس كل ما وصله من الكتابة الجيدة عبر التاريخ وفي مختلف الثقافات، وليس نجيب محفوظ فحسب.
ومن حيث التجربة؛ فالزمن هو الناقد الذي لا يخطئ في تقييم الأدب. نشهد الآن عودة إلى روايات نجيب محفوظ بشكل يفوق حضورها أثناء حياته، بينما اختفت نصوص تالية له بمجرد أن توقف أصحابها عن الركض لتثبيتها عبر حضورهم الشخصي وعلاقاتهم مع النقاد والميديا.
لا أشك أبداً في أن رهان نجيب محفوظ كان على الزمن، ولا أشك في أنه كسب الرهان. كانت معركته مع نفسه، وعندما تعود إلى أحاديثه تجده يبجل الجميع، ويثني على كتّاب أقل منه يحبون الفخر، وكانوا أكثر منه شهرة في زمانهم. وفي الوقت ذاته لم يلتفت إلى من حاولوا التقليل من شأن إبداعه ولم يزعجه التجاهل لوقت طويل. كان مثل عدَّاء المسافات الطويلة عينه على نقطة الوصول آخر المضمار.
• ماذا عن علاقتك الخاصة بأدب نجيب محفوظ ؟
•• علاقتي بكتابة نجيب محفوظ علاقة متطورة؛ لسببين: الأول يكمن في أدبية النص المحفوظي. والأدبية تعني تعدد طبقات النص، بحيث يحصل كل قارئ على مستوى من المعنى يناسب ثقافته، كما يحصل القارئ الواحد على معانٍ متجددة بالقراءات المتعددة للرواية الواحدة. هذا يعني أن السبب الثاني لتطور علاقتي بمحفوظ يرجع إلى تقدم وعيي به من قراءة لأخرى.
في البداية وصلني مستوى من مستويات الفهم والتفاعل، وعندما فاز بنوبل نشأ عندي سؤال من مقارنة جماهيريته بجماهيرية ماركيز. حصل الكاتب الكولومبي الأشهر على جائزة نوبل عام ١٩٨٢ وكان معروفاً على المستوى الدولي بشكل كبير، وساهمت الجائزة في مضاعفة جماهيريته، وعندما حصل نجيب محفوظ على الجائزة المرموقة، لفت الانتباه بالطبع إلى الأدب العربي كله، لكنه لم يصل إلى جماهيرية ماركيز.
هناك أسباب تنبع من ظروف لغتيّ الكاتبين؛ فالإسبانية لغة أوروبية، تدين لها الثقافة العالمية بسرفانتيس وصفّ طويل من الكتاب والشعراء قبل ماركيز، بخلاف العربية التي لا يتذكرها الغرب إلا من خلال ألف ليلة وليلة. لكن هناك ما يخصني شخصياً، إذ صار الفرق بين النجومية والقيمة واضحاً في ذهني بأكثر مما كان.
وعبر تأمل الكاتبين صرت أكثر انحيازاً لنجيب محفوظ. وفي زعمي أن ماركيز كاتب حار، يستخدم الكثير من التوابل في جملته، ويستخدم أسماء التفضيل المطلق: أجمل امرأة في العالم أجمل رجل غريق في العالم، وهكذا.
لا أقرأ الإسبانية لأفهم الفروق اللغوية بين رواياته، وهذه مسألة جوهرية، لكنني بالطبع أحس لغة نجيب محفوظ، وأعرف أنها لا تكون اللغة ذاتها في كل الأعمال، حيث تكون جزءاً من البناء يتناغم مع شخصيات وعالم كل رواية. وبهذا الصوت الخفيض يذهب محفوظ أبعد من ماركيز في الأسئلة حول الوجود والعدم وطبيعة الإنسان. والآن أراه واحداً من كتَّاب الإنسانية الكبار، يرتبط مباشرة مع عظماء مثل دوستويفسكي.
• تعددت أوجه التصنيف لكتابك الأخير «غرفة المسافرين» فهل يشغلك تجنيس النصّ الأدبي وأنت تكتب؟
•• غرفة المسافرين لديه الطموح ليكون كل هذا، وإلى أي حد تحقق هذا الطموح؟ لست المخول بالإجابة، بل القراء والقراء المهرة «النقاد». أما عن سؤالك إن كان التصنيف يشغلني؟ فجوابي: نعم ولا.
في البداية لا يشغلني التصنيف، لأن كل تجربة تختار نوعها الأفضل للتعبير عنها دون إرادة أو توجيه كبير مني. حيث لا ينفصل الشكل عن المعنى في الأدب، وكل معنى يختار الشكل الذي سيستريح فيه.
ولكن عندما أشرع في الكتابة لا بد من الوفاء للنوع الذي اخترته، وإلا ستصبح الأمور فوضى. السلطة تطغى أحياناً لكن اختفاءها مخيف، وأنا لا أريد لسلطة النقد أن تسقط بالكامل. النوع العابر للأجناس مسيرة في كتابتي بدأتها بـ«الأيك» عام ٢٠٠٢ بمجرد أن أكتب النص الأول فيه يتأسس الشكل، ولا بد للوفاء لهذا الشكل الذي كان اعتباطياً منذ لحظة. على أية حال أستمتع بكتابتي دائماً، وأنسجم مع شروط اللعبة في كل كتاب، وأمنحه كل قلبي كأنه الأول والأخير.
• لماذا اختلف قراؤك إذاً على تصنيف هذا الكتاب تحديداً؟
•• لا أعتقد أن «غرفة المسافرين» كتابي الأول الذي اختلف القراء حول تصنيفه، لكنه نال انتباهاً أكبر وانفتح على شركاء جدد، تبناه قراء مختلفون ربما. ومؤكد أنه حظي بدار نشر ممتازة، هو كتابي الثالث من «الدار المصرية اللبنانية» على التوالي، وهناك ربما تطور محمود في ظاهرة القراءة. الأيك مثلاً قوبل بحفاوة كبيرة في حين صدوره، وقد صدر في سلسلة «كتاب الهلال» وكانت طبعتها من عدة آلاف، وكنت وقتها أصغر مؤلف في تاريخ السلسلة منذ إضافتها لإصدارات دار الهلال العريقة عام ١٩٥٢. ولديَّ كذلك كل الرضا عن استقبال «كتاب الغواية» و«العار من الضفتين» وكتاب البورتريهات «ذهب وزجاج». لكن هذه المسيرة مع النص العابر للأجناس أثمرت أخيراً انتباهاً أكثر مع «غرفة المسافرين» دون أن تقل الحيرة النقدية تجاه هذا النوع.
لكنني أشعر بالغبطة لارتباط نصي بالذائقة الشبابية، وأعتبر نفسي نجوت من التقادم، وعليّ أن أواصل الانتباه لما أفعل.
• الاحتيال على القارئ، كيف يكون؟
•• دعنا نستخدم «اللعب» ذات المدلول الأفضل، حيث أصرُّ على أن الكتابة لعبة يلزمها اثنان. إن شئت هي كالحب. لا تكتمل الكتابة إلا بوجود قارئ، بل إن وجودها الحقيقي يبدأ مع أول قارئ يتلقاها ويتفاعل معها. الكثير من علاقات الحب تفشل في حالتين:عندما لا يعود لدى الحبيب شيء نجهله وعندما يظل لغزاً كاملاً، وكذلك العلاقة بين القارئ والكاتب لا يمكن أن تستمر عندما لا يكون لدى الكاتب ما يخفيه أو عندما يكون لديه ما يستغلق على القارئ بالمطلق.
لا بد من أن يكون النص قادراً على كسر أفق التلقي، وعندما يغلق الكاتب باباً، يتوجب عليه أن يمنح القارئ حزمة مفاتيح، وأن يكون بعضها قادراً على الفتح.
• ترجمة النصوص الأدبية إلى اللغات الأجنبية يراها بعض النقاد ظاهرة مرضيّة ترعرعت في الأوساط الأدبية العربية، هل الترجمة تعطي مشروعية للقيمة الأدبية لتلك النصوص؟
•• أعتقد أنني مع هؤلاء النقاد. القارئ الأجنبي ليس أفضل من قارئنا. الترجمة شيء جيد بوصفها إضافة للعدد الإجمالي للقراء. ويجب أن يؤرقنا عدد القراء إجمالاً؛ فرواية توزع عشرة آلاف نسخة في العربية لا بد أن تحقق رضا أكبر مما تحققه رواية توزع ألف نسخة في العربية وبضع مئات في بضع لغات. لدينا مشكلة حقيقية في القراءة. متكلمو العربية فوق 450 مليون نسمة، وتوزيع الكتب لا يتناسب أبداً مع هذا العدد، حيث يدور توزيع الروايات حول الألفي نسخة. حتى روايات «الأكثر مبيعاً» على المستوى العربي تدور حول العشرة آلاف بينما يوزع الكتاب الرصين هذا الرقم في لغة كالدانماركية التي لا يتكلمها أكثر من 5 ملايين.
ومع ذلك، فأنا أميل إلى تجاهل انخفاض معدل القراءة العربي، لكي أسأل نفسي عما ينقص نصي. في النهاية سباق الكاتب يجب أن يكون مع نفسه. وعليه أن يكون واعياً بالمتحقق في النصوص السابقة عليه والنصوص التي تُكتب حوله.
• عملت في الصحافة طويلاً، فماذا تغير في صحافة اليوم عن الأمس؟
•• ليس الكثير، وهذا بيت الداء وأصل المشكلة. منذ عقدين ونصف وجدت الصحافة نفسها في سباق مع وسائط جديدة مثل قنوات التليفزيون الفضائية وشبكة الإنترنت بتطبيقاتها المتعددة من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تنشر الخبر لحظة تحريره، بينما تحتاج الصحيفة إلى نحو ١٢ ساعة من الإعداد قبل الطبع. الحصان مصمم على إكمال السباق مع الصاروخ!
لكن للحصان جمالياته ومتعته. أنا أرى أن الصحافة الورقية قادرة على الحياة لكن في مضمار آخر. المادة المنشورة على الورق أعلى مصداقية؛ توحي بأن كاتب هذه الكلمة مستعد للوقوف خلفها والدفاع عنها، بعكس المنشور في المواقع الإلكترونية فهو يوحي بالهشاشة وسهولة المحو. الوصفة التي جربتها الصحف في اللغات الأخرى وبعض صحفنا العربية وإن بمعدل أقل هي الاتجاه إلى التحقيق الاستقصائي المعمق والقصة الإنسانية المطولة التي تقدم متعة القراءة إلى جانب وظيفتها في الإخبار. هذا يعني أن الصحافة يجب أن تختلف عن صحافة الأمس وتتشابه إلى صحافة أمس الأول. في النصف الأول من القرن العشرين كانت قصيدة الشعر تحتل مكان المقال الافتتاحي في صدر الصحيفة، وكان ثلث الصفحة الأولى من صحيفة «السياسة الأسبوعية» مخصصاً لباب عنوانه «في المرآة» يكتبه كبار الأدباء وهو عبارة عن بورتريه أدبي لشخصية، والكثير من هذه البورتريهات كان ساخراً. بعد الحرب العالمية الثانية تسلمت أمريكا قيادة العالم، وبدأت مدرستها الإخبارية في الانتشار، وهي في الحقيقة مدرسة تمارس التجهيل، حيث يركض القارئ من خبر إلى خبر، بحيث لا تستقر قضية لأكثر من يوم.
• اختلف كتّاب ونقّاد حول كتاب «المتن المجهول» لسيد محمود، وبالتحديد على أنّ محمود درويش صناعة مصرية، فيما كانت لك وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع، ما هي؟
•• كتبت مقالاً في جريدة «الشرق الأوسط» حول الكتاب، وهو كتاب شديد العذوبة، استطاع فيه سيد محمود أن يقدم سردية متماسكة لقصة محمود درويش في مصر، وينقل المناخ السياسي والثقافي مصرياً وعربياً ودولياً. وسبق أن احتفيت بكتاب محمد شعير «سيرة الرواية المحرمة» عن رواية أولاد حارتنا. الصحافة مهنتي وأغار عليها كما أغار على الأدب ومن هذه الزاوية تأتي حفاوتي بالكتابة الاستقصائية التي أرى أنها قادرة على تجديد شباب الصحافة.
أما عن جملة سيد محمود: «درويش صناعة مصرية» فهي مانشيت صحفي، يؤخذ في هذا الإطار، ونحن الصحفيين نميل أحياناً إلى بعض المبالغة، لكن في الأمر بعض الحقيقة. كان لدي صديق درَّس عاماً في كلية الإعلام وصرنا صديقين، هو الراحل وجدي زيد أستاذ الأدب الإنجليزي، وكان يردد على مسامعي كثيراً أن شكسبير صناعة دولة، وكان يعود فيشرح أنه يعني أن للاهتمام المتواصل بشكسبير دوره في الإبقاء عليه حياً، بخلاف دانتي مثلاً.
لا شك أن وقوف دولة بكل آلتها الثقافية والسياسية وراء مبدع يساهم كثيراً، بشرط أن يكون مبدعاً حقيقياً ولا يستنيم للدلال، ونحن نذكر مقال محمود درويش في تلك الحقبة: ارحمونا من هذا الحب القاسي. لقد كان في ذلك الوقت مشروع مبدع كبير يريد أن يحاسب على شعره لا أن نجامله لأنه يمثل قضية عادلة.
وقد لاحظت أن جدل الإنترنت ذهب في مكان آخر. هناك اتهام عربي جاهز للمصريين بالشوفينية الثقافية، وهو اتهام غير حقيقي بالمناسبة. ربما يلاحظ البعض أن المصريين يتابعون بقية العرب بصورة أقل، لكن هذا يرجع إلى اتساع الساحة المصرية، بحيث ينتهي العام قبل أن يتمكن القارئ من ملاحقة الكتب القريبة من يده، مسألة قرب وبعد وليس مسألة تعالٍ، كما أن هناك فجوة ضخمة بين سعر الكتاب المنتج في مصر وسعر المنتج خارجها.
• ماذا يعني لك السفر؟
•• هو فرصة للعيش الكثيف، وفرصة لانعتاق الروح من أثقال حقيقية أو متوهمة تكبلها لأنه يحقق لنا الانقطاع عن روتين كل يوم ومشاهد كل يوم في أماكن عيشنا الأصلية. لم أجرب السفر إلى النجوم وخبرة انعدام الجاذبية. هل يظل الإنسان في ذلك الظرف مقيداً إلى مشكلاته؟ أعتقد أن هذا غير ممكن، قياساً على ما جرَّبته في سفرياتي على الأرض. هناك تخفف من الثقل في السفر، وأظن أن المستوحدين والخجولين هم أحوج الناس إلى هذه الخفة التي يمنحها السفر.
• كيف يمكن للإنسان غير القادر على السفر في المكان أن يرحل في الزمان؟
•• سؤالك هذا هو أحد الأسباب التي أعطت «غرفة المسافرين» شكله. من جهة كونه سفراً في المدن والكتب في الوقت ذاته. غير القادر على السفر إلى مدينة يحبها يمكنه أن يسافر إليها من خلال كتاب، الباحث عن العبرة في الانتقال الجغرافي يجدها في كتاب كذلك. والعكس صحيح كذلك، فالسفر إلى أماكن مختلفة هو عيش حيوات مختلفة بما يضاعف أعمارنا المحدودة. السفر والقراءة يعمقان العيش، وحبذا لو امتلك الإنسان القدرة عليهما معاً.
• ماذا عن العزلة في حياة الأديب عزت القمحاوي؟
•• منذ أيام تهاتفت مع صديقة وسألتها الأسئلة المعتادة عن الأحوال، وردت بالجواب المعتاد منذ بداية كورونا، قالت: «كالعادة قاعدة مع نفسي» فقلت لها إذاً لست وحيدة، المشكلة إذا تركتك نفسك ونامت وقتها ستصبحين وحيدة. بعيداً عن المزاح، لن يعرف نفسه من لا يختلي بها. وأعتقد أن كل المبدعين فيهم مرض وموهبة العزلة بالميلاد، حتى الصاخبين أو من يبدون صاخبين مثل هيمنجواي. العزلة مطلب تحتاجه الكتابة، ويقدر عليه من يولد به. أتذكر أنني كنت دائماً طفلاً منعزلاً، وألاحظ أنني أعود من اللقاءات العامة -على ندرتها- بأقل عدد من أرقام التليفون. أحب الكثير من الناس، ولو كانت لدي قدرة على تلبية هذا الحب بالتواصل، ربما كنت أحظى بحياة أسعد، لكن حياة العزلة أوسع وأكثر أمناً.
• هل بالفعل، أفلت عزت القمحاوي من فخ البدايات المرتبكة؟
•• هناك عيوب للبدايات لا يمكن لأحد أن ينجو منها. وقد كان الراحل الكبير سيد حامد النسَّاج أول من احتفى بمجموعتي القصصية الأولى «حدث في بلاد التراب والطين» وأشار في مقال له، إلى سلامة اللغة معتبراً أن هذه القصص لا تبدو كتابة أولى لصاحبها. لم يزل هناك محبون للمجموعة الأولى، لكن سلامة وربما «اكتمال اللغة» الذي أشار إليه د.النسَّاج هو مصدر العيب، وأنني أفلتُ من فخ البدايات المرتبكة إلى فخ البدايات المحكومة جيداً.
أعتقد أن طموح الاكتمال يوقع البدايات في عيوب تشبه عيوب الارتباك. كنت في ذلك الوقت أريد أن أكون مرئياً، ألا يعيب عليَّ أحدهم، بعد ذلك استرحت لمفهوم اللعب أكثر، والحرص على أن تشبه اللغة عالمها، لا أن تكون كاملة. لا مجال للثرثرة في لغة عالم تحكمه الأوامر في رواية «الحارس» لكن التكرار سيكون جزءاً من الحماسة الطفولية في رواية «ما رآه سامي يعقوب» فسامي يحب البشر والأشياء أو يكرهها جداً جداً، وهكذا.
• وكيف تكون الكتابة لعباً؟
•• أنت تطلب مني أن أصف إحساساً. عندما أكون مستمتعاً أعرف أنه لعب، وعندما تبدأ المعاناة أعرف أنني انتقلت من مربع اللعب إلى مربع الشغل. وهذا يخيفني ويجعلني أتوقف لحين استئناف العذوبة أو الانصراف كلياً عن إكمال النص. أتصور أن اللعب في الكتابة هو ترك مساحات للعشوائية والصدفة، والسخرية. أرى أن السخرية هي أصل الفنتازيا والخيال الجامح. والعكس صحيح كذلك.
الكاريكاتير، عمل انتقادي ساخر، لكنه فانتازي كذلك. الطريقة التي يبالغ بها رسَّام الكاريكاتير في تكبير أنف كبير أوجعل فم صغير بالغ الصغر ينتج في النهاية ملامح ساخرة لشخص نعرفه في الواقع، لكن الرسم يجعله فنتازياً، فليس هناك شخص في الواقع وجهه مجرد أنف، أو فمه لا يتسع سوى لقشة امتصاص العصير!
• هناك من يرى أن السخرية والحكمة تلازمان عزت القمحاوي في كتابته، هل هاتان صفتان مطلوبتان في الكتابة الإبداعية؟
•• السخرية والحكمة طموحي، وأن يتحقق منهما شيء فهذا يسعدني. أحب النكتة، وأحب من يلقيها بشكل جيد؛ هي فن من فنون التأليف والأداء. والنكتة هي الطموح الذي يمكن أن تتمناه الكتابة قصيدة كانت أو قصة أو رواية، من حيث إحكام وتضافر الشكل والمعنى. هي وجهة نظر وراءها ذكاء وخفة روح تحتاجها الكتابة بالطبع.
• هل ما تكتبه مخطط مسبقاً؟
•• لا كتابة يمكن أن تأتي من غير مثير أو متغير في الواقع، والكاتب يستجيب لهذا الحراك. ولا أعني بالواقع الارتباط بالحادث العارض حولنا، بل أعني شرط وجودنا نفسه. محدودية عمرنا هي نفسها واقع يدفع الإنسان على محاولة ترك ما يطيل ذكره في الحياة، ولو عبر إنجاب طفل.
وأن ينجذب أحدنا ليكون كاتباً فهذه خطة بحد ذاتها، وستولد في نفسه أسئلة تفجرها جملة أو حدث صغير أو لحظة تأمل، بعد ذلك تكبر الفكرة لتصبح موضوعاً هو بمثابة روح لا بد أن تحل في جسد لكي تكون مرئية، وهي تتعرف على شكلها، وتدفع الكاتب إلى اختيار الشكل، بنوع من الحدس وليس القرار. لا أخطط الكتابة لكن أتصور بشكل تقريبي شكلها وحجمها، وقد يخرج التنفيذ مختلفاً لهذا التصور.
• وهل ترى فيما تكتب بناء غير مسبوق في الكتابة المصرية والعربية كما يقول بعض المعجبين بما تكتب؟
•• عندما يرى الكاتب ذلك يكون قد كتب شهادة وفاته بنفسه. العلم يمكن أن تحكمه ذروة واحدة ويمكن للعالم أن يتوصل إلى اكتشاف لم يسبقه إليه غيره، في الأدب متسع لتجاور الجميل، وليس هناك جديد لنصل إليه ونكتشفه لكن المتعة في الرحلة، ويمكن لكل كاتب جديد أن يطمح إلى صحبة حسنة مع القارئ في رحلة ممتعة. الشيء الوحيد الأكيد عندي أنني لا أسرق وقتاً من كتاب أكتبه، ولا أترك نصاً من يدي إلا بعد أن أستنفد جهدي وأستنفد كل قدراتي على الإضافة.
• الناقد الدكتور عبدالدائم السلامي يسأل عمّا تطلبه الرواية من قارئها؟
•• للناقد أن يطلب من القارئ، فهو القاضي بين النص والقارئ. والدكتور عبدالدائم السلامي عالج هذا الأمر في كتابه النابه «النص المُعنَّف» لكن الكاتب لا يطلب من القارئ لأن الزبون على حق. (أضحك طبعاً، لأن الزبونية أحد الضغوط الواقعة على الأدب الآن).
في الحقيقة أن امتلاك القارئ لمعرفة جيدة بالمجاز والاهتمام الجيد بما يقرأه يجعله يستمتع أكثر ويستفيد أكثر من اللعبة. نصوص نجيب محفوظ قرأتها السينما من السطح، وهناك الكثير من القراء قرأوها واستمتعوا، لكنهم مثل من يذهب إلى النهر ليغترف منه بدلو مثقوب، عندما يصل إلى نهاية الرواية سيجد في يده دلواً غير ملآن. بمران القراءة المستمر، وقبل ذلك بالتعليم الجيد يستطيع القارئ أن يسد ثقوب دلوه ويقرأ «الحرافيش» بوصفها أسئلة حول الوجود والعدم، حول القوة والحق وحول جوهر السلطة والحرية.
• الروائي السعودي طاهر الزهراني يسأل عن تصوّرك للأسلوب الخاصّ؟
•• أعتقد أن الأسلوب جزء من تكوين الكاتب ونتيجة لهذا التكوين، نتيجة غير إرادية في الأغلب ناتجة عن قراءاته السابقة وتفضيلاته الجمالية وتكوينه الخِلقي والنفسي حتى؛ فأثر كف البصر بادٍ في أسلوب طه حسين الإيقاعي، لغته صوتية مصقولة، فالأذن أقدر على الفرز من العين، في المقابل نجد أسلوب العقاد متغطرساً كشخصيته يتحرى الجامد من الكلمات. لا ينجو كاتب الرواية من هذه الآثار التي تطبع أسلوبه، لكن داخل السمات العامة لا بد أن يجتهد لكي تكون لديه أساليب وليس أسلوباً واحداً، بحيث تتناغم اللغة مع عالم كل رواية. هكذا نرى في «الحرافيش» بداية أقرب إلى الشعر، تحيل إلى صوت القدر في الشكل الملحمي، بينما في «اللص والكلاب» نجد بداية إخبارية تناسب عالم نوفيلا صغيرة تتابع سجيناً خرج للتو، ويريد الانتقام ممن غدروا به.
• قارئ يسأل عن التاريخ الذي تراه علماً لا يُنتفع به؟
•• هذه ملاحظة أبديها دائماً عندما أرى أن البشر يريدون لمس النار مرة بعد مرة ليعرفوا أنها تحرق. الحضارات تقوم وتزدهر وتضمحل بالطريقة نفسها دون أن تستفيد واحدة مما جرى لسابقاتها عندما فسدت أو استرخت، ولا يستفيد حاكم ممن سبقه. في مجال الأدب كذلك أرى التاريخ علماً لا يُنتفع به؛ فالبعض يكرس وقته للعلاقات العامة وليس لتحسين نصه. وهذا سعي يحقق بعض المنافع العابرة مهما كانت كبيرة، وبعد ذلك يأتي حكم الزمن الذي لا يخطئ؛ فيُبقي على نجيب محفوظ ويتجاهل من كانوا نجوماً في عصره.
• قارئ آخر يسأل عن الكاتب الذي يلجأ للتجريب عندما يعجز عن الكتابة بشكل جيد؟
•• هذا السؤال يكاد يكون حكماً على كاتب محدد في ذهن السائل أو لعله يرى نماذج من الألغاز وليس نموذجاً واحداً جعله يسأل هذا السؤال. الصيغة توحي كذلك بأن التجريب المقصود هو تجريب في الشكل. وأنا هنا ألتزم بجوابي على سؤال سابق. ليفعل الكاتب ما يريد على أن يضع في يد القارئ مفاتيح للنص. الإنسان عدو ما يجهل، ولا يمكن لأحد أن يستسيغ الطلاسم.
لكن التجريب ضرورة ومسؤولية وليس باباً للهروب. والكاتب الذي لا يجرب وليست لديه مراحل تختلف باختلاف الزمن ليس كاتباً كبيراً، بل صنايعي يعرف طريقاً آمناً ويسير فيه. كما أن التجريب ليس في الشكل فحسب، هناك التجريب في الشخصية وفي اختبار الأفكار. ظل نجيب محفوظ يختبر فكرته عن الوجود في عدد من الروايات: أولاد حارتنا، الطريق، وغيرها، وبلغت المعالجة ذروة إحكامها في «الحرافيش» كذلك كان المُعلم الأكبر دوستويفسكي يجرب بناء شخصية من عمل إلى عمل، كأنه عالم نووي يجرب تحفيز الذرات، ليرى ما سيحصل عليه في كل مرة، وأحياناً ما يكون السابق أكثر كمالاً من اللاحق، لكن قلق الفنان جعله يحاول مجدداً رسم صورة القديس من خلال «أليوشا» في رواية «الأخوة كارامازوف» بعد أن رسم «الأمير مشكين» في «الأبله» كما نرى الشخص المتأرجح على الحافة بين استعذاب الإهانة وإيلام الآخرين في عدد من الشخصيات، وتصل التجربة في النهاية إلى مارميلادوف والد سونيا الغارق في ضعفه ووضاعته في «الجريمة والعقاب» ثم نراها في الوالد فيودور كارمازوف الغارق في الضعة والاستقواء.