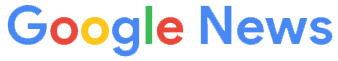نظرا إلى النفور الحالي بين السياسات العربية واليهودية علينا أن نغذّي ذاكراتنا بأمور يمارس محوها -عن قصد- من نتحدث عنهم على أنهم اليهود وهم في الحقيقة (صهيونيون) انعزاليون ومهووسون بأن يكونوا وطنا واسعا، يجدر بنا أن نتذكر أن هنالك تاريخا طويلا من الاحترام المتبادل بين الجماعتين. فمثلا عندما (أجْبِرَ) الفيلسوف الهندي (ابن ميمون) على الهجرة من أوروبا المتشددة في القرن الثاني عشر الميلادي وجد ملجأً متسامحا في (العالم العربي) ولم يكن مُضيفه الذي منحه منصبا محترما ومؤثرا في بلاطه في (القاهرة) سوى الإمبراطور صلاح الدين الأيوبي الذي لايمكننا الشك في إسلامه بعد دوره الباسل في مقاومة الحملات الصليبية دفاعا عن الإسلام.
والواقع أن تجربة (ابن ميمون) رغم بلاغتها لم تكن متفردة، ففي الحقيقة أنه على الرغم من أن العالم المعاصر ممتلئ بالصراعات بين المسلمين واليهود فإن الحكّام المسلمين في العالم العربي وخصوصا بالأندلس في العصر الوسيط لهم تاريخ عريض من محاولات (دمج) اليهود كأعضاء (آمنين) في الجماعة المشتركة التي تحترم حرياتها وأحيانا أدوارها القيادية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكرت (ماريا روزا مينوكال) في كتابها (زينة العالم) The Omament Of The World فإنه بالوصول الى القرن العاشر الميلادي كانت منجزات قرطبة في الأندلس الإسلامية في قلب المنافسة الجادة مثل بغداد وربما أكثر على لقب (أكثر الأماكن تحضرا على وجه الأرض)! والحق أن هنالك براهين عدة -كما تؤكد مينوكال- على أن وضعية اليهود بعد الفتح الإسلامي (شهدت تحسنا واضحا من كل الوجوه، حيث انتقلوا من أقلية مضطهدة إلى أخرى -تتمتع- بالحماية)*.
إنّ هويتنا الدينية والحضارية ينبغي أن تكون شديدة الأهمية، لكنها عضوية جماعة واحدة من بين (جماعات) كثيرة، يتمتع بعضويتها كلّ منا. إن السؤال الذي ينبغي أن نسأله ليس ما إذا كان الإسلام (أو الهندوسية أو المسيحية) دينا محبا للسلام أو محبا للحرب؟! . لكن كيف يمكن أن يجمع المتديّن (مسلما أو مسيحيا أو هندوسيا) بين معتقداته أو ممارساته الدينية والملامح الأخرى لهويته والالتزامات والقيم الشخصية (مثل موقفه من الحرب أو السلام). لهذا نؤكد أن النظرة إلى شخص ما باعتبارها هوية (تبتلعه) فإن ذلك لتشخيص عميق الإشكالية ويتضمن خطابا عنصريا ومعوّقا.
ومن بين أتباع هذا الدين الواسع / الفسيح / المتعايش، طلعت علينا جماعات ذات مسميات متعددة الأسماء والألقاب تنظر إلى الحياة محصورة في الشعائر وتتمسك بالنوافل وتعتبر أن العالم (شديد) القبح. ومما يعزّز هذه النظرة المفاهيم الاجتماعية التي تخلط (عن جهل) الدين بالعادات أو بمعنى أدقّ (الفولكلور) وانحياز المجتمع ضد الثقافة باعتبار أن الثقافة (شيطان) مهما ادعى العاملون في حقل الثقافة. وهذا الوضع مرتبط بقصتنا التي بدأنا بها مقالنا. فالنادي الأدبي يقوم في كلّ مدينة يوجد بها إلى (مجاملات) لكبار الشخصيات الاجتماعية بل وفي بعضها يتوّج بمركز في مجلس الإدارة ربما يكون ليس مؤهلا للمكان الذي يشغله. وهنا يبرز وجود المنتفعين كأحد وجوه المعاناة الثقافية التي تحاول أسماء رائدة ومتنوّرة أن يجعل منها موجودة لدى الجماهير مع وجبات طعامهم. لأنه -في الحقيقة- فإن الثقافة جزء من احتياجات الإنسان وذلك لتكتمل الصورة التي أرادها الخالق عزّ وجلّ للإنسان أي: في أحسن تقويم.
ولكنّك تضطر لمثل هكذا اصطدامات بسبب تخلي المسؤولين الجديين وليس المتطوعين! وأعني أنه ليس بيد المثقف -سواء كان مشهورا ويتمتع بنجومية اجتماعية أم بسيطا كمطر- أيّ سلطة ليحدد أهدافا معينة. وإن كثيرا من المثقفين هم أشبه بجلساء مقاه.
هل سمعتم مثلا أن النادي الأدبي بالرياض قد كرم روح الراحل العظيم (عبدالله نور)؟! أو أقام أمسية شبيهة لتكريم الحاضرة والمزهرة (أميمة الخميس) أو رصد مبلغا ماليا كبيرا لجذب الرأسمال الثقافي بالمغرب والمشرق بعُمان والكويت وبيروت يكون موضوعها غير مقيّد بتقاليد جوائز أخرى؟!
لقد رميت الكرة. فمن سيلعب بها؟
jalhomaid@yahoo.com
والواقع أن تجربة (ابن ميمون) رغم بلاغتها لم تكن متفردة، ففي الحقيقة أنه على الرغم من أن العالم المعاصر ممتلئ بالصراعات بين المسلمين واليهود فإن الحكّام المسلمين في العالم العربي وخصوصا بالأندلس في العصر الوسيط لهم تاريخ عريض من محاولات (دمج) اليهود كأعضاء (آمنين) في الجماعة المشتركة التي تحترم حرياتها وأحيانا أدوارها القيادية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكرت (ماريا روزا مينوكال) في كتابها (زينة العالم) The Omament Of The World فإنه بالوصول الى القرن العاشر الميلادي كانت منجزات قرطبة في الأندلس الإسلامية في قلب المنافسة الجادة مثل بغداد وربما أكثر على لقب (أكثر الأماكن تحضرا على وجه الأرض)! والحق أن هنالك براهين عدة -كما تؤكد مينوكال- على أن وضعية اليهود بعد الفتح الإسلامي (شهدت تحسنا واضحا من كل الوجوه، حيث انتقلوا من أقلية مضطهدة إلى أخرى -تتمتع- بالحماية)*.
إنّ هويتنا الدينية والحضارية ينبغي أن تكون شديدة الأهمية، لكنها عضوية جماعة واحدة من بين (جماعات) كثيرة، يتمتع بعضويتها كلّ منا. إن السؤال الذي ينبغي أن نسأله ليس ما إذا كان الإسلام (أو الهندوسية أو المسيحية) دينا محبا للسلام أو محبا للحرب؟! . لكن كيف يمكن أن يجمع المتديّن (مسلما أو مسيحيا أو هندوسيا) بين معتقداته أو ممارساته الدينية والملامح الأخرى لهويته والالتزامات والقيم الشخصية (مثل موقفه من الحرب أو السلام). لهذا نؤكد أن النظرة إلى شخص ما باعتبارها هوية (تبتلعه) فإن ذلك لتشخيص عميق الإشكالية ويتضمن خطابا عنصريا ومعوّقا.
ومن بين أتباع هذا الدين الواسع / الفسيح / المتعايش، طلعت علينا جماعات ذات مسميات متعددة الأسماء والألقاب تنظر إلى الحياة محصورة في الشعائر وتتمسك بالنوافل وتعتبر أن العالم (شديد) القبح. ومما يعزّز هذه النظرة المفاهيم الاجتماعية التي تخلط (عن جهل) الدين بالعادات أو بمعنى أدقّ (الفولكلور) وانحياز المجتمع ضد الثقافة باعتبار أن الثقافة (شيطان) مهما ادعى العاملون في حقل الثقافة. وهذا الوضع مرتبط بقصتنا التي بدأنا بها مقالنا. فالنادي الأدبي يقوم في كلّ مدينة يوجد بها إلى (مجاملات) لكبار الشخصيات الاجتماعية بل وفي بعضها يتوّج بمركز في مجلس الإدارة ربما يكون ليس مؤهلا للمكان الذي يشغله. وهنا يبرز وجود المنتفعين كأحد وجوه المعاناة الثقافية التي تحاول أسماء رائدة ومتنوّرة أن يجعل منها موجودة لدى الجماهير مع وجبات طعامهم. لأنه -في الحقيقة- فإن الثقافة جزء من احتياجات الإنسان وذلك لتكتمل الصورة التي أرادها الخالق عزّ وجلّ للإنسان أي: في أحسن تقويم.
ولكنّك تضطر لمثل هكذا اصطدامات بسبب تخلي المسؤولين الجديين وليس المتطوعين! وأعني أنه ليس بيد المثقف -سواء كان مشهورا ويتمتع بنجومية اجتماعية أم بسيطا كمطر- أيّ سلطة ليحدد أهدافا معينة. وإن كثيرا من المثقفين هم أشبه بجلساء مقاه.
هل سمعتم مثلا أن النادي الأدبي بالرياض قد كرم روح الراحل العظيم (عبدالله نور)؟! أو أقام أمسية شبيهة لتكريم الحاضرة والمزهرة (أميمة الخميس) أو رصد مبلغا ماليا كبيرا لجذب الرأسمال الثقافي بالمغرب والمشرق بعُمان والكويت وبيروت يكون موضوعها غير مقيّد بتقاليد جوائز أخرى؟!
لقد رميت الكرة. فمن سيلعب بها؟
jalhomaid@yahoo.com