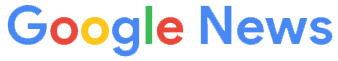في بيت متواضع صغير أنيق على مقربة من المسجد الحرام عشت طفولتي وصِباي أذكر في طفولتي ثلاثة أشياء كانت توقظني من النوم عند الفجر دعاء أمي عقب الصلاة وقد كانت ترتله بخشوع ونبرة حزينة متوسلة وعندما كانت تصل بدعائها إلى هذه النجوى المؤثرة المريرة «ياربي لا تحوجني وأبنائي إلا لوجهك الكريم يا كريم» يخف صوتها ويصير نشجيا موجعا.. غناء «السماوار» حين يغلي وتنتشر رائحة الشاي الأليف.. وصباح مكة يستيقظ مع صياح الديكة تعلن من أعالي البيوت المكاوية القصيرة الارتفاع عن مولد نهار جديد.. وهديل الحمام ينتشر خافتا رقيقا عند الغبش مستقبلا نجمة الصبح فتبتهج لغنائه القباب والمآذن الذهبية.. كنت أذهب إليها احتضنها وهي تداعب مسبحتها البنية الخشبية أحتضن نهر الحنان الذي لا يملك زواياه ولكنه يداهم جميع الحواس.. اعتادت أمي، بعد أن نتناول طعام الإفطار والذي غالبا لم يكن يتجاوز رغيفا ذهبيا محمصا من فرن عمي «عبد العال» وجبنة بيضاء من دكان «عبده وزان» وشاي معطر برائحة يديها، أن تقص علي حكاية قبل أن أذهب إلى المدرسة وبعد أن تنتهي الحكاية كانت توصيني أن أحترم معلمي وأطيعه وأحب الجيران وأراعي شعور زملائي وأن لا أؤذي كلبا ولا قطا ولا أمد يدي إلى حاجة تعود إلى غيري وبهذه الأفعال الطيبة تكون لي حسنات بها يدخلني الله الجنة حيث ألتقي فيها بكل الأطفال الطيبين الذين ماتوا وهم صغار وقريبتنا «فائقة» التي كنت أحبها والتهمتها النار وحيث سأنعم ببساتين فيها أشجار ونخيل وأعناب وتين ورمان وفيها نهر من عسل وآخر من لبن وفيها.. وفيها.. وكنت على الرغم من هذا الوصف البديع للجنة أسألها أيمكنني يا أمي أن أخرج من الجنة وأزور أهل الحي وبيتي هذا وألتقي بأترابي من التلاميذ في المدرسة وألعب معهم ومع حمام البيت؟؟ فكانت تجيبني أن الجنة بعيدة جدا فقد شيدها الله في أعالي السماوات لا يمكنك النزول منها لتزور مدينتك وبيتك وتلتقي بأترابك التلاميذ وتلعب معهم ومع الحمام فكنت أجيبها بتفكيري المتواضع الضئيل ما دامت الجنة تبعدني عن كل ما أحب وعن كل من أحب فأنا لا أريد الدخول إليها!!.. كانت تمسح بيدها على رأسي وتقول لي سيكون معك هناك كل الوجوه العزيزة الكريمة من جيراننا وأنا كذلك وسنجتمع مع أبيك الذي فقدته وسيأخذك في نزهة معه في البساتين الجميلة سيحضنك وسيلعب معك فقد أشتاق هو إليك أيضا وسيكون لنا بيت فاره فخم ضخم فيه كل ما تريده وهناك لن تبكي أبدا فكل اللحظات سعيدة.. هكذا كانت تصور لي أمي الجنة وأنا في السابعة من العمر.. ربيعا يتجدد وفالا حسنا وشوقا إلى نسيم لقاء الأحبة وماء يتدفق عذبا عميقا.. جنة الحمام والورود والأحلام الفارهة.. كنت أقبلها بعد ذلك وأفتتح صباحاتي بسماع «جعجعة الرحى».. مطحنة أبي كان أبي «طحانا» رحمة الله عليه كان أول من يستقبلني عم «محمد برناوي» بلونه الداكن جالسا أمام «حوش» المطحنة يطعم كلبا شاحبا هزيلا، كنت أسأله عن سبب ألفته لهذا الحيوان، كان يقول لي إنه زائر كريم لا يثقل علي بزياراته إلا إذا استبد به الجوع وأنا أطعمه كل يوم لأدخل الجنة، كنت أطيل الوقوف عنده ولا أتركه حتى يلتئم شمل العمال وتتعالى «جعجعة الرحى» لازلت أذكر بعض العاملين الذين كانوا يعملون في أجواء أليفة وكان صوت الماء ينبعث من الحوض المائي المرطب لسخونة الرحى يضيف للصباح لمعانا وفتنة، أذهب للمدرسة بعد ذلك على قدمي، المدرسة «(المشعلية» مدرسة كنت أشهد فيها كل يوم تحية العلم مع أترابي التلاميذ وأطرب لرنين الجرس عند الانصراف منها والعودة للبيت حيث تستقبلني أمي عند عتبته مشرقة فرحة، «المشعلية» لا أذكر يوما عدت فيها إلى مدينتي العزيزة مكة زائرا لها إلا وتوقفت قليلا على بابها وحتى أزيلت بالكامل كما أزيلت أشياء كثيرة عزيزة أخرى معها لازالت صور أليفة تمر بي وأنا شيخ عبث به الزمن واعتصرته الأيام ولم يتبق عنده إلا ذاكرته.. ذاكرتي هذه هي مركبتي التي تبحر بي نحو الأليف والمضيء والناصع وهي ذخيرتي وزادي وهي خمرتي التي أنسى بها مر الحياة وأتذكر حلوها وجميلها وأبتسم.. تظل أياما خضراء كنخلة سعف.. أياما وردية حميمة دافئة عشتها بين أناس كانوا أوسع أفقا وأكثر انفتاحا على نوافذ العقول الصغيرة تجاوزت نظرتهم حدود «الحور العين والبكاري العذارى».. شيء من الذاكرة أنبشه لكم اليوم من الأعماق أنتقي منها ما يستحق أن يدون قبل أن يواريها ويواريني الزمن بتراب النسيان!!.