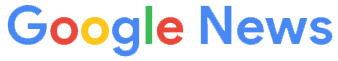ذهب (جنون البقر)، وبقي جنون بعض البشر بعقولهم وقلوبهم التي تضيق بالحق وبشركاء الحياة وبالرأي الآخر، بل بالآخر بالمطلق، وتضخمت (الأنا)، بينما الإنسان السوي يلتزم الصدق قولا وعملا بنقاء النفس وتجنب الضغائن، وفي هذا تكمن التقوى التي حثنا عليها ديننا الحنيف، ورسولنا الكريم ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ الأسوة الحسنة، ولطالما كان أهلنا الأسبقون، وإلى عهد قريب، أكثر حرصا على حسن المعاملة وصدق التعامل والتعاون على البر والتقوى وبذل النصيحة والاستجابة لها، فصدقت العبادات بالمعاملات.
البعض يفهم البذل والإحسان على أنه بالمال، وقد يجود به وقد يبخل، لكن الإحسان أشمل وأعمق، كما قال ــ صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، وهكذا يبدأ بالصدق والإخلاص سرا وعلانية، ودائما ما تتناول خطب الجمعة والدروس والبرامج الدينية هذا الأمر، لكن كم من الناس يحسن السمع ويصلح شأنه؟!
إن المشاعر السلبية من مكر وبغي على حقوق الغير باتت أقرب إلى نفس الكثيرين، وضعفت حقوق القربى والجار والزمالة وحق المجتمع إلا من رحم ربي، وفوق ذلك الانشغال عن التنشئة الإيجابية للأجيال، وغلبت المصالح الشخصية على العامة، وتغول جشع الغش والغلاء وقسوة القلوب واحتقار الضعفاء، وتجبر أزواج على زوجاتهم، وانشغلت زوجات عن بيوتهن، ففسدت العلاقات وزادت المشاحنات والمشكلات ومعدلات الطلاق، بل ومعدلات الاكتئاب.
هذه ليست نظرة تشاؤمية، وإنما هو الواقع، وأكثر من ذلك غرق الإعلام في فتن السياسة والاقتتال الدامي في أنحاء واسعة من أمتنا التي قال فيها الحق ــ تبارك وتعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) إلى آخر الآية. كما أن شبكات التواصل في العالم الافتراضي مرآة عاكسة للحقيقة العارية لصناع الضغائن وفحش القول وعصابات الفتن الذين اختطفوا تعاليم الإسلام السمح والقيم الجميلة، وهؤلاء ينطبق عليهم قوله سبحانه (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد).
إذا انشغل مجتمعنا عن تنبيه الغافلين، والغفلة عن المسيئين وعن جنون المتطرفين، فمتى وكيف تستعيد قيمها الأصيلة وثقافة الحقوق والواجبات. قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وقال ــ صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا..)، تلك هي قضايانا الأهم التي إذا بدأنا علاجها سنصلح الكثير من أحوالنا وواقعنا ــ بإذن الله.
البعض يفهم البذل والإحسان على أنه بالمال، وقد يجود به وقد يبخل، لكن الإحسان أشمل وأعمق، كما قال ــ صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)، وهكذا يبدأ بالصدق والإخلاص سرا وعلانية، ودائما ما تتناول خطب الجمعة والدروس والبرامج الدينية هذا الأمر، لكن كم من الناس يحسن السمع ويصلح شأنه؟!
إن المشاعر السلبية من مكر وبغي على حقوق الغير باتت أقرب إلى نفس الكثيرين، وضعفت حقوق القربى والجار والزمالة وحق المجتمع إلا من رحم ربي، وفوق ذلك الانشغال عن التنشئة الإيجابية للأجيال، وغلبت المصالح الشخصية على العامة، وتغول جشع الغش والغلاء وقسوة القلوب واحتقار الضعفاء، وتجبر أزواج على زوجاتهم، وانشغلت زوجات عن بيوتهن، ففسدت العلاقات وزادت المشاحنات والمشكلات ومعدلات الطلاق، بل ومعدلات الاكتئاب.
هذه ليست نظرة تشاؤمية، وإنما هو الواقع، وأكثر من ذلك غرق الإعلام في فتن السياسة والاقتتال الدامي في أنحاء واسعة من أمتنا التي قال فيها الحق ــ تبارك وتعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) إلى آخر الآية. كما أن شبكات التواصل في العالم الافتراضي مرآة عاكسة للحقيقة العارية لصناع الضغائن وفحش القول وعصابات الفتن الذين اختطفوا تعاليم الإسلام السمح والقيم الجميلة، وهؤلاء ينطبق عليهم قوله سبحانه (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد).
إذا انشغل مجتمعنا عن تنبيه الغافلين، والغفلة عن المسيئين وعن جنون المتطرفين، فمتى وكيف تستعيد قيمها الأصيلة وثقافة الحقوق والواجبات. قال تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، وقال ــ صلى الله عليه وسلم: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا..)، تلك هي قضايانا الأهم التي إذا بدأنا علاجها سنصلح الكثير من أحوالنا وواقعنا ــ بإذن الله.