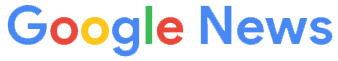استعرض الناقد والمثقف سعيد السريحي ورقة نقدية بعنوان «نحو فقه جديد للغة» اليوم (الأربعاء) في النادي الأدبي بجدة.
وقال السريحي «عادت الطفلة من ذات السنوات الأربعة من مدرستها، أخبرت والديها أنها تجلس بجوار بكر في الفصل، وفي اليوم التالي اشتكت لهم أن بكر أخذ مرسامها، وفي اليوم الثالث عادت تبكي لأن بكر ضربها في الفسحة، اتصلت والدة الطفلة على إدارة المدرسة وأخبرتهم بما يحدث من بكر لابنتهم، ويبدو أن إدارة المدرسة استدعت والدي بكر لأن ابنتهم أخبرتهم أن ام بكر وأبوه حضرا إلى المدرسة، غير أنها أضافت: أمه بكر وأبوه بكر، ضحك والدا الطفلة ولم يستوعبا ما قالته طفلتهما».
وأضاف«تعرضت الطفلة بعد عدة أيام لوعكة صحية فأخذتها أمها إلى المستشفى، وحين كانت الطبيبة تفحصها همست الطفلة لأمها: بكر، ولم تفهم الأم ما عنته طفلتها ببكر وهي تشير إلى الطبيبة، غير أنها قررت أن تزور المدرسة في اليوم التالي تحمل التقرير الطبي الذي يبرر غياب ابنتها وتتعرف على بكر الذي أبوه بكر وأمه بكر والطبيبة التي عالجت ابنتها بكر كذلك، وحين رأت الأم بكرا تبين لها ما كان يعنيه بكر لطفلتها، كان بكر الفتى الوحيد في الفصل ذو البشرة السوداء، وكانت الطبيبة سوداء البشرة كذلك، وإذا كان ذلك كذلك فلا غرابة أن يكون والد بكر ووالدته بكر كذلك».
وذكر «لم يكن بكر مجرد اسم لذلك الطفل، لم تكن تعرف معنى أن يكون للإنسان اسم كذلك، حين رأته لم تر فيه غير ما يميزه عن بقية التلاميذ في الفصل، لون بشرته، وحين سمعتهم ينادونه بكر لم يكن لبكر معنى غير ذلك اللون الذي يميزه، ولذلك حين رأت والدته ووالده، وحين رأت الطبيبة كذلك، رأتهم جميعا بكرا».
وتابع «الاسم ليس الشيء وإنما هو تصور الشيء، هكذا تعلمنا حكاية تلك الطفلة مع بكر، وهذا التصور خاص جدا، فردي جدا، ولا سبيل لنا كي نفهمه إلا بالعودة إلى ما يرد فيه من سياقات، وقد كان والد بكر ووالدته وكذلك الطبيبة السياقات التي حلت لغز بكر الذي حير والدي الطفلة، لندع الطفلة وبكر ووالديه والطبيبة ولنقف مع الطفل الذي كان يقف أمام البحر، تتلبسه الحيرة، يصم أذنيه هدير موجه، تسكن عينيه زرقته، ويهوله امتداده الذي يبدو أن لا نهاية له، وحين يتقدم خطوة لتلامس قدماه الماء يجذبه أبواه بعيدا عنه ويسمعهما يحذرانه من البحر».
وقال السريحي «البحر.. تسكنه الكلمة، يرددها فيطمئن ابواه إلى أنه تعلم كلمة لا يشكان في دلالتها على ما تعنيه، دلالة وثقها إصبعه وهو يشير إلى البحر متلعثما: بحر، في يوم تال يرفع الطفل نفسه سبابته إلى السماء متأتئا: بحر، يصحح له أبواه: سماء، لا يفقه لم هي ليست بحرا كما قالا له بالأمس، ويتعجبان كيف سمى السماء بحرا وقد أوقفاه على البحر حتى اطمأنا إلى معرفته به».
وزاد «اطمأن الأبوان لمعرفة طفلهما باسم البحر الذي يعرفانه، ولم يخطر ببالهما ما الذي يمكن أن يعنيه البحر لطفل يحاصره ألف معنى للبحر في ذلك الموقف، وحين سمّى السماء بحرا تكشف أن ما أستقر للبحر معنى في تصوره إنما هو اللون الأزرق الذي يمتد حتى الأفق، ولعل الطفل لو وقف أمام أرض فضاء لا نهاية لها لسماها بحرا، فقد لا يكون للبحر عنده من معنى غير ذلك الامتداد الذي لا يبلغ بصره مداه».
وذكر «وليس ببعيد أن يسمى كل ما يمكن أن يستدعي منه الحذر ويثير في نفسه الفزع بحرا، فلا يزال يستحضر فزع أبويه وتحذيرهما له حين هم بالاقتراب من ذلك الذي سمياه بحرا وخافا عليه منه».
وقال «وإذا كان وقوف الطفل أمام البحر يشكل سياقا يربط بين البحر وتسميته فإن سبابته التي تشير إلى السماء أو الأرض الفضاء أو ما يضطرب في صدره من خوف هي السياقات التي تكشف عن كلمة تطفو على وجه دلالات لا تستقر على واحدة منها، ولا يكاد يجمع بينها غير تلك التجربة التي لا تكشف عن مداها كلمة وإنما تتراءى فيما تحيل إليه تلك السياقات».
وأضاف «تلك هي تجربة الإنسان مع اللغة، حقيقة ليست كالحقيقة التي انتهى إليها المتكلمون، ومجاز ليس كالمجاز الذي استقر معناه عند البلاغيين، وإنما هي»حقيقة«لا تقوم إلا في اللغة التي تحتضن تجربة الإنسان الأولى مع ما يحيط به وتلّمسه الطريق لمعرفته، وإذا ما اعتبرناها»مجازا«حين نقرنها بما انتهى إليه وعينا بالعالم، فإن علينا أن نعتبرها»حقيقة«حين نعيدها إلى مهادها الذي ولدت فيه محفوفة بقلق الإنسان الذي يقلب وجهه فيما حوله كلما لمح وجه شبه بين هذا وذاك راح يسميه بما يراه فيه، يسميه بزاوية العين كما قال هيدجر، لا حقيقة لشيءٍ غير ما يراه في ذلك الشيء، لا حقيقة خارج معرفة الإنسان بالشيء معرفة مبنية على الحدس، تجربة تلتقي فيها الأشباه والنظائر وتنبثق منها النقائض والاضداد، كأنما الكلمات مرايا تتراءى فيها الكائنات، يغدو معها البحر ماء وترابا، عذبا وأجاجا، وارضا وسماء. مصطرعا لدلالات لا تجمع بينها غير التجربة الأولى للإنسان».
وقال«تلك هي التجربة الأولى مع اللغة، تجربة الإنسان حين كانت اللغة التي يمتلكها قليلة والعالم من حوله كثير، التجربة التي تتأسس عليها معان وعلاقات تتأبى على المنطق أن يحتويها وعلى مقولاته أن تحيط بها، وقد حفظت لنا معاجم اللغة أطرافا من تلك التجربة يمكن تبيّنها مما كان يحرص اللغويون على الاستشهاد به مما وصل إليهم من كلام العرب شعرا ونثرا، ولو أننا قلبنا المعاجم لنقف على ذلك البحر الذي تراءى للطفل سماء وماء وبرا ومبعثا للخوف والفزع لأسعفتنا تلك المعاجم بما لا يبتعد كثيرا عن تجربة ذلك الطفل مما يعزز النظر إلى ربط نشأة اللغة ب»طفولة«الإنسان على وجه الأرض».
وأشار إلى أن الدلالة تجمع على «الماء الكثير» بين البحر والنهر، فيغدو كل منهما بحرا، لا تميز عذوبة أحدهما وملوحة الآخر بينهما، جاء في تاج العروس: البحر: الماء الكثير، ملحا كان أو عذبا سمي بذلك لعمقه واتساعه، قال ابن سيدة: وكل نهر عظيم بحر، وقال الزجاج: وكل نهر لا ينقطع ماؤه فهو بحر، قال الأزهري: كل نهر لا ينقطه ماؤه مثل دجلة والنيل وما أشبههما من الأنهار العذبة الكبار فهو بحر، وأما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فلا يكون ماؤه إلا ملحا أجاجا، ولا يكون ماؤه إلا راكدا، وأما هذه الأنهار العذبة فماؤها جارٍ.
وقال «الملوحة والعذوبة تتراجع أمام دهشة التجربة المتمثلة في الوقوف أمام الماء، بحرا كان أو نهرا، جاريا كان أو راكدا، كأنما هي تجربة الإنسان قبل أن يقدم على ارتشاف رشفة من هذا أو رشفة من ذاك فيعرف ما بينهما من اختلاف، البحر يحتضن تجربة أولى في التسمية سابقة على التمييز بين ما هو عذب ومالح وراكد وجارٍ».
وأضاف «غير أن سبر ملامح تلك التجربة لا يلبث أن يتصل ببعد آخر لها يتمثل فيما يجمع بين البحر والنهر من حيث كون كليهما»شق في الأرض«على نحو ما علل به ابن سيدة تسمية الانهار بحارا»لأنها مشقوقة في الأرض شقا«وقال الأزهري: البحر في كلام العرب الشق، ويقال:إنما سمي البحر بحرا لأنه شق الأرض شقا، وجعل ذلك الشق لمائه قرارا، وفي حديث عبد المطلب:»وحفر زمزم ثم بحرها بحرا «أي شقها ووسعها».
وذكر «تلك الدلالة لا تلبث أن تفتح التسمية على كل ما هو شق فيغدو شق الأذن بحرا، وبحر الناقة والشاة يبحرها بحرا إذا شق أذنها بنصفين، وقيل بنصفين طولا، وكانت العرب إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها إذا شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تحلّأ عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى، وإذا لقيها المعيي المنقطع به لم يركبها، وجاء في الحديث:»أول من بحر البحائر وحمى الحمى وغير دين إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف".
وزاد «غير أن التجربة لا تنحصر في كثرة الماء أو شق الأرض وإنما تنفتح كذلك على»الاتساع العظيم"، قال ابن بري: إنما سمي البحر بحرا لسعته وانبساطه، ولذلك تغدو الأرض المنبسطة بحرة، قال نصر: البحار: الواسعة من الأرض، الواحدة بحرة، والرياض المنبسطة بحار كذلك، قال النمر بن تولب:
وكأنها دَقَرى تُخايل نبتها أُنفٌ يَعُمُّ الضال نبت بحارها
وقال «ولا يلبث هذا الاتساع الذي يجمع بين البر والبحر أن يفرغ البحر من مائه حتى يغدو البحر برا ممتلأ بالماء كما هي البحرة أرض متسعة لا ماء فيها، وعليه فسر الحديث (الطهور ماؤه) فثمة بحر هو هذه الأرض المتسعة وماء طهور يملأها، وللتجربة مع البحر حضورها حين لا يمس البحر شيئا إلا أحاله بحرا أو نسب إلى البحر، فتغدو القرى والمدن التي على حافة البحر بحارا، وعليه ذهب الزجاج إلى أن معنى قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر) أي ظهر الجدب في البر والقحط في مدن البحر التي على الأنهار، وحسبُ الصحابية اسماء بنت عميس أن تركب البحر لكي تصبح بحرية، (وكانت أسماء بنت عميس يقال لها البحرية لأنها كانت هاجرت فركبت البحر)».
وأضاف «وتتبدى لنا حالة الخوف التي تحف بالتجربة مع البحر وراء قولهم: بحِر الرجل يبحَر إذا تحيّر من الفزع، وبحر الرجل والبعير أذا اجتهد في العدو طالبا أو مطلوبا فضعف وانقطع حتى اسودّ وجهه وتغيّر، وأبحر الرجل إذا أخذه السلّ ورجل بحير وبحِرٌ مسلولٌ ذاهبُ اللحم، والبحر هو الهلاك وعلى ذلك فسّر ثعلب قوله»يا هادي الليل جرت، إنما هو الفجر أو البحر«فقال إنما هو الهلاك أو ترى الفجر، وسمت العرب البحر عوطبا، قال الأصمعي هي من العطب، أي الهلاك، وقال ابن الأعرابي العوطب أعمق موضع في البحر».
وتابع «والتجربة الأولى للإنسان مع البحر، والتي لا تزال تتراءى لنا حية غضة في اللغة، هي تلك التجربة التي تستمد منها الأحلام خيالاتها ورؤاها، وإليها يركن من يحاولون تفسير الأحلام وفك مغاليق رموزها، وإذا كان للبحر في اللغة حضور مهيمن على ما حوله فله في الحلم نفس الحضورالذي يمكن ان نقف عليه في عند ابن سيرين حين يقول (أما البحر فدال على كل من له سلطان على الخلق كالملوك والسلاطين والجباة والحكام والعلماء والسادات والأزواج لقوته وعظيم خطره وأخذه وإعطائه وماله وعلمه... وربما دل البحر على الدنيا وأهوالها، تعزّ واحدا وتموله، وتفقر آخر وتقتله)».
وقال «وقد استحضر ابن حجة الحموي سلطان البحر في وصف ما عاناه من أهواله عند رحلته من طرابلس الشام إلى مصر فقال:(يا مولانا، وأبثك ما لاقيت من أهوال البحر وأحدث عنه ولا حرج، فكم وقع المملوك من أعاريضه في زحاف تقطع منه القللب لما دخل إلى دوائر تلك اللجج، وشاهدت منه سلطانا جائرا يأخذ كل سفينة غصبا، ونظرت إلى الجواري الحسان وقد رمت أزر قلوعها وهي بين يديه لقلة رجالها تسبى..)».
وزاد «تلك هي التجربة مع البحر بما تنفتح عليه من آفاق متباينة، لا يغدو معها البحر بحرا ولا البر برا ولا المالح مالحا ولا العذب عذبا، يلتقي فيها الإنسان البحير والناقة البحيرة وقد ذهب لحم الأول بالسل وتحررت الأخرى فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تذبح ولا تذاد عن ماء أو مرعى، وإذا كانت التجربة الأولى قد تركت لنا هذه الدلالات التي تنفتح على كل هذه الآفاق لم يكن بوسعنا أن نتحدث عن مجاز يختصر الحقيقة اللغوية في عمليات آلية يتم من خلالها نقل الكلمة وفق معايير ومقولات عقلية تقوم على التشبيه وتهدف إلى التأكيد وتسلك سبيل المبالغة».
وأكد السريحي «إذا كانت التجربة الأولى قد تركت لنا كل هذه الدلالات لم يكن بوسعنا كذلك أن نتحدث عن حقيقة كتلك الحقيقة التي تجعل من كلمة بحر دالة على البحر الذي نقف على شاطئه ونركب سفنه ونصطاد أسماكه، للبحر حقيقته اللغوية التي تستعلي عما بتنا نوجز فيها معناه ونحتصر دلالاته، البحر هو المجاز إلى كل هذ التجربة بما لها من معان ودلالات متقاربة ومتباعدة، والبحر هو الحقيقة باعتبارها كل ما يمكن أن تحمله الكلمة من دلالات لا تزال تجربة الإنسان الأول حية غضة فيها».
وقد كان اللغويون أقرب إلى تفهم هذه الحقيقة اللغوية حينما كانوا يقلبون معاني البحر ليسكشفوا ما يترامى إليه من معان لا يمكن كشفها إلا من خلال السياقات التي يرد فيها فأقروا أن البحر اسم للماء مالحا وعذبا وللأرض المتسعة يابسة وماء دون حاجة إلى إدعاء المجاز في تلك التسميات.
وقال السريحي «غير أن كتب اللغة نفسها لم تكن تسلم من آفة القول بالمجاز كذلك فذهبت إلى أن دلالة البحر على الرجل الكريم والفرس من باب المجاز، وقد كان الأجدر بهذه التجربة التي جعلت من البحر اسما للبر وما يجري فيه من ماء وما يقوم فيه من مدن وقرى أن تطّرد فيكون منهاا تسمية الرجل الكريم بحرا والفرس السريع العدو بحرا والعالم الغزير العلم بحرا دون أن يُحمل شيء من ذلك محمل المجاز الذي حملها عليه صاحب تاج العروس حين قال ( ومن المجاز: البحر: الرجل الكريم، الكثير المعروف، سمي لسعة كرمه، ومن المجاز البحر: الفرس الجواد الواسع الجري)».
وأشار إلى أن القول بالمجاز كما انتهى إليه أمره لدى البلاغيين ينبني على نزع الكلمة من سياقها، وتقييدها بمعنى محدد تم وضعها له، ومن ثم اختصار العلاقة بين ما وضعت له وما نقلت إليه في علاقات تحتكم لمقولات المنطق، وقد أفضى ذلك إلى تغييب أصل اللغة باعتبارها تعبيرا إنسانيا ينبثق من تجربة أولى للإنسان، تجربة وجودية قلقة تعبر عن القلق الإنساني والحيرة أمام عالم تحيط معالمه بالإنسان يسعى إلى التعرف عليها بقدر ما يستشعر ما يمكن أن يشكله من تهديد لوجوده حين كان غريبا على الأرض.
وأضاف "والمنطق الذي بنت عليه البلاغة أقانيمها، بما تستوجبه من علاقات بين الكلمات، يقتضي أن يكون للبحر ماهية تحدد حقيقته وتميزه عن غيره، وأن لغيره ماهيات متمايزة عنه، وهو ضرب من التفكير الذي انتهى إليه النظر العقلي للعالم في أطوار متأخرة من تطور المعرفة، إن حُمِلت عليه اللغة في جانبها العملي الذي لا يتجاوز الوظيفة الإيصالية لها فليس له أن تُحمل عليه اللغة باعتبارها تجربة إنسانية عميقة الجذور تتجلى في الشعر سبقت هذا الضرب من النظر بأزمنة موغلة في القدم، غير أن هذه الجذور بقيت كامنة فيها تتجلى فيما تأخذه البلاغة على أنه تجوّز في استخدام الكلمات ثم تسعى إلى تفسير ما قام عليه ذلك التجوّز بضرب من القول يعزز تلك المقولات التي تم الاحتكام إليها، وكأنما المنطق وآلياته قد وجد مذ وُجد الإنسان فعليه تأسست لغته وتحددت كلماته الدالة على ماهية الاشياء، كما تحددت بناء على تلك المقولات العلاقات بين تلك الكلمات والطرائق التي يتم نقلها بها من معنى وضعت له إلى معنى استخدمت فيه.
وتابع «ومنطق اللغة غير ذلك المنطق، والتسمية إحالة لتجربة لا يمكن تصؤها بالنظر العقلي للاشياء، تجربة تُخرج الأشياء من شيئيتها كي تسبغ عليها وجودا إنسانيا، معنى تتصاقب فيه الكلمات وتلتقي فيه الكائنات ويتخذ من لحظة الحدس معتركا له، فلا يصبح للشيء وجودا في ذاته وإنما هو الوجود الذي يقوم في وعي الإنسان به، وجودا سابقا على الماهية وجود لا وجود للشيء قبله، وجود تتنزل معه تلك القدرة على التسمية التي منحها الله للإنسان بمنزلة إعادة خلق الاشياء في أسمائها أو باسمائها، وإلى تلك القدرة تعود اللغة وعليها ينبغي أن تحمل».